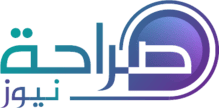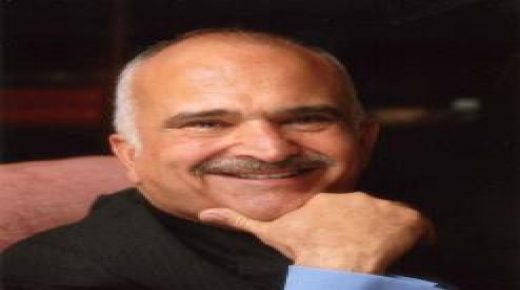صراحة نيوز – مقالة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال والتي صدرت في الصحف المحلية اليوم بالتزامن مع صحيفة العرب اللندنية…
ما نواجهه اليوم عالمياً من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية مترتبة على انتشار وباء كورونا “Covid-19″، هو بحدّ ذاته تحدٍّ لمعرفة مدى تجذُّر مفهوم المواطنة الفاعلة لدى كل واحد منا، ويشكِّل اختباراً لقدرتنا على الانتقال من محدودية “الأنا”، إلى رحابة المفهوم الجامع لمدلولات التآلف والتضامن والتعاضد (نحن)؛ وبخاصة من حيث توافر القدرة للإنسان الواعي على التفاعل مع قضايا مجتمعه ووطنه والمجتمع الإنساني ككل، مما يؤكد ضرورة السعي إلى بناء عالم اجتماعي يتميز بالفاعلية وبالانخراط الشخصي في التفاعل مع الآخرين.
وإذا اعتبرنا أننا أمام حرب عالمية جديدة ضد وباء اجتاح 159 بلداً في العالم، فإن الأسئلة التي تتعمق فينا تدور حول ما إذا كان الوباء الفعلي أمامنا أم خلفنا؟ وهل باستطاعتنا في إطار استيعاب البُعد العالمي الأشمل لهذا التحدّي أن نصمد بالجدية اللازمة والصبر المطلوب لنخرج من متوالية الأزمات الماثلة أقوى من ذي قبل؟
إنَّ الإجابة على مثل هذه التساؤلات ينبغي أن تستند إلى حدس البداهة في أنَّ المسؤولية الإنسانية والأخلاقية هي معيار العمل، يدا بيد، خلال المرحلة المقبلة، من أجل زيادة الوعي وتعزيز القيم الأساسية التي تشكِّل جوهر إنسانيتنا، وأعني بها تحديداً الرحمة والتعاطف والاحترام والتشاركية. وفوق هذا كلّه لا بد من تعظيم الروح الجماعية بمعنى “weness” أو تأكيد المفهوم الجمعي المرتبط بضمير “نحن”، وتقديم الصالح العام على فردية “الأنا”.
وليس من سبيل إلى ذلك إلَا بوقوفنا صفا واحداً في عملٍ جماعي حقيقي يتجاوز حالة التمنّي إلى مواجهة مباشرة لتداعيات هذا الانتشار الوبائي أو الجائحة العالمية، والعمل بمنهج تغليب العقل والحكمة، وإيثار تقديم العون والمساعدة بكل ما نستطيع، من أجل إعلاء شأن الكرامة الإنسانية، وأن يكون الشعور مع الآخرين والتعاطف مع المرضى والمنكوبين نابعاً من عمقنا الحضاري الإنساني، كما جاء في الحديث الشريف “مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى” (أخرجه البخاري ومسلم).
على الإنسانية، بأسرها، أن تتحد وتنسّق الجهود وتشارك المعلومات والمعرفة للخروج من هذه الفاجعة العالمية، التي أصابت الجميع دون تمييز بين الأغنياء والفقراء، والشيوخ والأطفال، وكذلك بين الأعراق والألوان والمعتقدات. فالجميع في موضع الخطر أمام وباء سريع الانتشار. وعلى الرغم من كل التقدّم العلمي والطبي الذي نشهده، فإن الحل الوحيد للخروج من أيّ أزمة يبدأ بالوعي والتضامن وترسيخ مبدأ الأمن الديمقراطي.
هذه الأوقات الاستثنائية تُعدُّ فرصة للتواضع والاعتراف بمحدوديتنا كبشر، وحاجتنا لأن نتشارك معاً في العمل لتحقيق النفع العام ومصلحة المجموع. وفي هذا المجال تبرز أهمية التشبيك والتنسيق بين الجهات المختلفة، واستنفار طاقاتنا في التواصل الفعّال وحُسن التصرف والأداء الأفضل، ضمن الإطار الوطني؛ الحكومي والأهلي والفردي على السواء، لإيجاد دينامياتٍ من التفاعل، وإعادة بناء الثقة بين الجهات المقدمة للخدمات (حكومية كانت أم أهلية) والجمهور.
وفي سياق إدارة الأزمات، لا بد لنا أيضاً من معالجة أزمة الأفكار والفراغ، فهناك من الدواعي والأسباب ما يحتّم ملء هذا الفراغ عبر تعزيز التفاعل بين الجامعات ومراكز الفكر والدراسات والنقابات والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني كافة.
كما يقع علينا واجب التعلّم من الآخرين والبناء على الدروس المستفادة من تجاربهم، ونحن نُعيد التفكير فيما ننفق وما نقتني، بحيث نفكر أكثر بالآخر المُقابِل، وندرك مغزى ما تقوم به المؤسسات الدولية من تأكيد الحفاظ على الهوية والالتزام بالعمل المشترك، وهذا لا يعفينا من التساؤل: أيننا من إقامة بنك إقليمي للإعمار بعد الحروب؟ وأين نحن من مشروع مؤسسة عالمية للزكاة والتكافل الإنساني؟ فنحن نتحدث عن الزكاة بهذا المفهوم في إطار الخدمة الإنسانية للجميع. وفي قوله تعالى “يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ”(الانشقاق:6)، نجد الخالق – عزَّ وجَلّ – يخاطب الإنسان مترفقاً به، عطوفاً عليه، داعياً إياه إلى العمل الجادّ والمسؤول، فالدين في خدمة الإنسانية.
إننا جزء من العالم البشري علينا ما على الآخرين من واجبات، ولنا ما لهم من حقوق، ومن هنا يتحدَّد دور كل جزء في المجموع ومسؤوليته على مبدأ المساواة، وترتسم حلقات الامتداد الحضاري في عملية التواصل والحركة الحيوية الدائمة والمُحرِّكة للعلاقة العضوية بين الجزء والكلّ.
لقد أنتجت الهجرات الجماعية عبر القرنين الماضيين أعداداً كبيرة من المهجريين العرب في الأميركيتين، تساوي في حجمها نصف مجموع سكان الوطن العربي، وبالرّغم من أن كل جيل قد يظن أنه أمام حدث غير مسبوق في بعض الحالات، إلَا أن التاريخ المستمرّ الذي لا يعيد نفسه يعلّمنا بأن ذلك ليس صحيحاً. فنحن أبناء التجربة الحضارية الإنسانية في حكم التاريخ ولسنا بمعزل عن شركائنا في كل ما يجمع البشرية من أواصر وصلات. ولا نخطئ هذا المفهوم التواصلي حينما نُعَدّ امتداداً لآسيا كما نحن بمثابة امتداد لأوروبا، وكما أن امتدادنا ليس مقتصراً على الشرق، وإنما يصل إلى الغرب الذي يمكن أن يُعدّ أيضاً من جهة أخرى امتدادا لنا.
غايتنا أن نبحث عن السلام الداخلي في مكنوناتنا، وعن السلام فيما بيننا. فالسلام لا يعني غياب الحرب فقط؛ بل يعني النهضة والتنوير، ولنا في الوحدة الأوروبية القائمة على السلم مقياساً وحُجّة على أهمية المنحى السلميّ.
ويظلّ السؤال المشروع: كيف ننهض من فواجعنا؟ إن ذلك لن يتأتّى لنا إلا من خلال تفعيل رصيد أساسي من الفكر والإرادة، لأن الأفكار أهمّ من المال. فهل نستطيع أن نطبق هذا المفهوم على شبابنا وهم يهاجرون بمئات الألوف لدول مختلفة؟ كيف نعطي لشبابنا معنى حقيقياً للحياة؟ كيف نواجه التحديات الثلاثة المتمثلة بالكوارث التي اقترفها الإنسان؛ والحروب المستعرة بين الإنسان وأخيه الإنسان؛ والكوارث التي من صنع الطبيعة مثل التصحر والجفاف والتمدين غير المنضبط على حساب الأرض، هذه وحدها كافية لكي نعيد النظر في أولوياتنا.
إذن، علينا إعطاء الفكر محتوى جديداً، نبحث فيه عن أقطاب البوصلة في دعوتنا لبناء محتوى المشاركة العلمية والتطبيقية، سواء في الصحة أو التربية أو البيئة المكانية والإنسانية والجغرافية، وعلى رأس من نعنيهم بذلك الشباب من الوطن والمهجّر، فالدمج بين العلوم الطبيعية والإنسانية هو ما يشكل تقدماً كبيراً في فهمنا لبناء المعرفة المشتركة، وتعزيز البحث العلمي والفكر العلمي الناقد. وفي هذا المجال علينا الاعتراف بأن الضغط الأدبي من الشباب مقبول في سياق التطوير الفكري والقيمي لتطوير التعليم وبرامج الصحة الوقائية قبل العلاجية.
علينا كذلك أن نعمل على أنسنة البيئة المكانية والإنسانية، ونطوّر من مفاعيل الهوية في إطار المقاصد العليا للدين. وهنا نستطيع التحدّث عن دساتير شرف ومواثيق أخلاقية وتضامن أخلاقي في مجالات أوسع من المصالح والمنافع الضيقة.
لا شك أن الأولويات لا يمكن أن يحددها الوضع الاقتصادي فقط كما حصل في بعض الدول، بل يجب التفكير ملياً والتروّي وإيثار الكرامة الانسانية، فالبعد الأخلاقي للأزمة هو امتحان لضمير الأطباء والمرضى والمواطنين على حد سواء؛ في بناء مجتمعات أكثر مناعة تقاوم الأمراض والفايروسات التي قد تهاجم العالم في المستقبل، والعمل لبلورة رؤية إنسانية واضحة نحو العلم والتكنولوجيا تقتضي تلبية حاجات الفقراء والمهمشين والضعفاء من الخدمات والمنتجات بوصفها أولوية في أعلى قائمة الأولويات.
ولا ننسى هنا أهمية بناء “المناعة النفسية” والارتقاء بمستوى تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي لحماية أنفسنا والآخرين. فالتكامل المتناغم للجسد والعقل والبيئة هو الأساس في بناء مجتمع أكثر صحة وأمانا.
وفي سياق تفعيل التواصل الإلكتروني واللقاء الافتراضي إلى حين انتهاء الأزمة، لا بد من العمل عبر وسائل التكنولوجيا المختلفة على بثّ روح الأمل والتذكير بفاعلية الإيمان التي تعظّم في نفوسنا مشتركاتنا الإيمانية والإنسانية، بدلاً من نشر الشائعات واللغو والغيبة والشماتة بمعاناة الآخرين وآلامهم واغتيال الشخصية. فالظروف الاستثنائية تبرّر التضييق في حدود الحقوق والحريات الدستورية بالقدر الكافي للتعاطي معها، فمبدأ سيادة القانون والدولة القانونية وإنْ كان يصلح في الظروف العادية، إلا أنه وعند تعرض مكوّنات الدولة للخطر يكون تقديم الصالح العام على حقوق الأفراد مصلحة عامة، بحيث نعود نتفيأ بظلال المشروعية بعد الانتهاء من هذه الأيام الاستثنائية. كما علينا أن نؤمن بقدرة الإنسان على الإبداع كي نجسّد معاً قدرتنا على الصمود وإعادة البناء والتجديد بعيداً عن أيّ اختلافات قد تقسمنا وتخلخل التماسك الاجتماعي.
كلّي أمل بقدرتنا على تجاوز هذه المحنة، وأؤكد أن مستقبلنا لا يعتمد فقط على مجرد اكتشاف الحلول العلمية لمشكلاتنا فقط، بل يعتمد أيضاً على اتفاقنا بأن التطور العلمي يجب أن يوجّه من أجل خير البشرية ورفاهها والذي يجب أن يكون أساس جهود التنمية.
لقد كنا بحاجة إلى صدمة قوية توقظ ضميرنا الإنساني، وتخرجنا من وهم التسلّط والتفوق، والشعور الخادع بالاستغناء عن الآخرين والابتعاد عن الخلق الإيماني الإنساني. إنها لحظة تاريخية اجتمعت فيها مخاوف البشرية وآمالهم وشعورهم بوحدة همومهم ومصيرهم المشترك. فالالتفات إلى التاريخ يكون بالنهضة والتنوير، وليس بإعادة التاريخ إلى زوايا الفناء، كما كان الحال مع بعض الحضارات قبل الميلاد. وأقول إنَّ التاريخ هو مُعلّمٌ حكيم للتغيير حين يصلح الإنسان من أمره في تغييرٍ يتماشى مع وضعه وحياته ومستقبل إنسانيته.