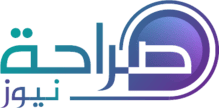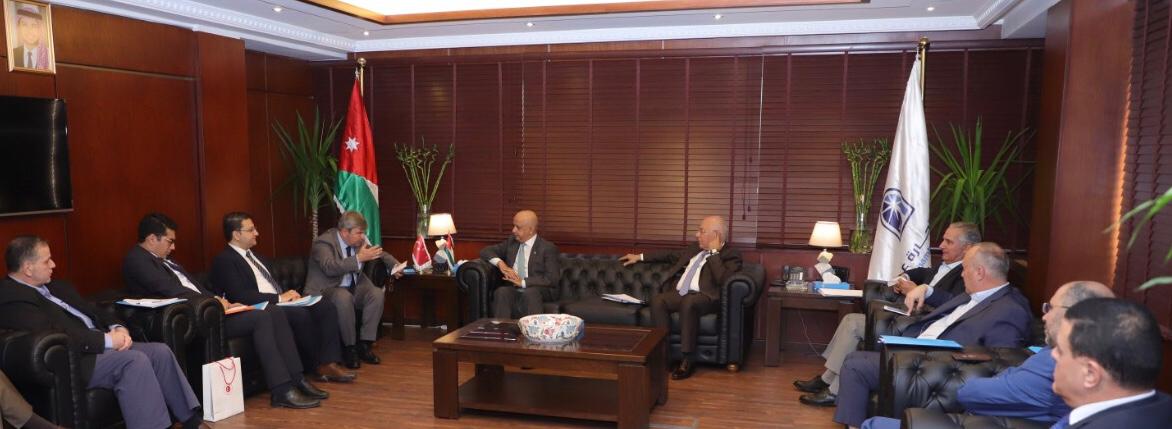صراحة نيوز – بقلم الدكتور محمدأبو حمور
تمثل المديونية إحدى أهم المشكلات التي تواجه البلدان النامية عموماً، وذلك نظراً لأبعادها السلبية في التأثير على عملية التنمية، وتهديدها لاستقرار النظام المالي، وبالتالي انعكاس التأثير على الأمن الوطني لهذه الدول. ويشير تقرير إحدى المؤسسات الدولية المتخصصةإلى أن اقتراض البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وصل إلى (607 ) مليارات دولار عام 2017 ،مقابل (181 ) مليار دولار في العام السابق، وهو أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات،وفقاً لإحصاءات الديون الدولية. كما ارتفع إجمالي الدين المستحق للدائنين الرسميين والخارجيين على هذه البلدان إلى ( 7.1 ) تريليون دولار أو بنسبة ( 10 % ) عام 2017 .ويشير التقرير نفسه إلى أن تزايد الأعباء على تلك البلدان يترافق مع تزايد القلق بشأن الدين العالمي الإجمالي، الذي يزداد حسب بعض التقديرات بنسبة (60 % ) عما كان عليه قبل الأزمة المالية عام 2008.
في أواسط عام 2004 كان الأردن قد تخرَّج أو أنهى العمل ببرامج صندوق النقدالدولي التي استمرت حوالي خمسة عشر عاماً وبدأ مرحلة الاعتماد على الجهود الذاتية والوطنية للإصلاح.وأشادت في حينها مختلف التقارير الاقتصادية، المحلية منها والدولية، بالإنجازات التي حققها الأردن في أثناء تطبيقه برنامج الإصلاح.
وعملياً فقد تم تحقيق إنجازات لافتة مثل انخفاض عجز الموازنة بعد المساعدات إلى حوالي (2،7 % ) من الناتج المحلي الاجمالي في أعقاب وصوله إلى ما يزيد على ( 20 % ) في بداية تطبيق البرنامج عام 1989 .كما انخفضت نسبة الدين العام إلى ما يقارب (90% ) من الناتج المحلي الإجمالي؛ مقارنة مع نسبة (220 % ) في بداية الفترة ذاتها. وبشكل عام فقد استعاد الاقتصاد الأردني عافيته وبدأ مرحلة جديدة من النمو المضطرد، الذي انعكست آثاره على سائر الجوانب الاقتصادية.
لكن يبدو أن الركون إلى الثقة المبالغ بها حول أداء الاقتصاد الوطني دفع بالجهات المسؤولة إلى التراخي في ضبط أمور المالية العامة؛إذ شهدت النفقات العامة ابتداءً من عام 2005 نمواً متسارعاً وخاصة النفقات الجارية منها، دون أن يرافق ذلك جهود فاعلة لتأمين إيرادات محلية تغطي ذلك النمو، مما أدى إلى ارتفاع معدل الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.
ومما ساعد على زيادة الأمور سوءاً اندلاع الأزمة المالية العالمية التي كان لها انعكاسات واضحة على مختلف الدول، وبالتالي عاد الأردن مجدداً إلى حظيرة البرامج الإصلاحية التي تُنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في صيف عام 2012 بعد أن توصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق.
ولا شك بأن التردي في الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة يعود في جزءٍ كبيرٍ منه إلى المؤثرات الخارجية، سواءً ما يتعلق منها بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، أو بأحداث الربيع العربي، ومن ثم انقطاع الغاز المصري، وأخيراً الأزمة السورية التي أدَّت إلى توافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى المملكة. ونتيجة لكل هذه المعطيات، فقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى ( 95.4 % ) في نهاية الربع الثالث عام 2018،ومؤخراً تم الإعلان أنه، وحسب الأرقام الأولية،فقد بلغت نسبة الدين العام في نهاية عام 2018 حوالي ( 94 % )
وبالرغم من أن الأردن كان دائماً عُرضة للتطورات الإقليمية غير الملائمة، إلاّ أنه حافظ على استقراره بشكل يُثير الإعجاب، وهذا يقودنا إلى حقيقة أساسية وهي أننا في المملكة قد لا نستطيع تغيير طبيعة الأحداث من حولنا،غير أنه يجب أن نكون قادرين على التعامل مع هذه الظروف بكفاءة وفاعلية، وبحيث نمتلك الأدوات اللازمة لتحويل التهديدات إلى فرص سانحة. وهذه المهمة غير السهلة لا تقع على كاهل الحكومة فقط، وإنما يجب أن تكون مهمة مشتركة مع مكوّنات الدولة الأردنية كافة.
مفهوم الأمن الوطني والعلاقة بين الأمن والاقتصاد
يُعدّ الأمن من أهم الاحتياجات البشرية وأكثرها ضرورة بصفته مقوِّماً أساسياً للحياة الإنسانية،وقد توسع هذا المفهوم في تطور لافت بعد أن أصبحت هناك منظومة أمن وطني تشمل الأمن السياسي والعسكري والاقتصادي والبيئي،فضلاً عن الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي.
يقول روبرت ماكنمارا، وزير الدفاع الأميركي الأسبق ورئيس البنك الدولي سابقًا، في كتابه «جوهر الأمن»: «ليس الأمن هو المعدّات العسكرية وإنْ كان يتضمنها، ولا هو القوة العسكرية وإن كان يتضمنها، ولا هو النشاط العسكري وإن كان يتضمنه، إنَّ الأمن هو التنمية، ومن دون التنمية لا يوجد أمن، والدول التي لا تنمو لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة».
إن العلاقة بين الأمن والتنمية هي علاقة تبادلية جدلية، فليس هناك تنمية بلا أمن، ولا أمن بلا تنمية، ولا يمكن أن تنجح مشاريع تنموية في ظل صراعات ونزاعات وحروب، كما لا يعقل أن يعمّ الأمن في ظل غياب تنمية تلبي حاجات المواطنين وطموحاتهم،وترفع من مستوى معيشتهم. ويمكن القول إنّ الأمن والتنمية هما عنصران متلازمان، وأي خلل في أحدهما ينعكس سلباً على الآخر، كما أن أي استقرار أو تطور محمود فيهما ينعكس إيجاباً عليهما معاً.
فالأمن شرط أساسي للبناء الاقتصادي ومن دونه لا يمكن تأسيس اقتصاد مزدهر، ومن جانب آخر فإن الاقتصاد الذي ينمو بنسب جيدة وُيوجد فرص عمل للمواطنين يعتبر وسيلة ناجحة للحفاظ على الاستقرار ويحفِّز على تعزيز الأمن. ولا شك أن تعزيز دور الاقتصاد في الحفاظ على الأمن الوطني لا يتطلب فقط بناء استراتيجيات ملائمة لمكافحة الفقر والبطالة، وإنما أيضاً تشريعات ملائمة لمكافحة الفساد والمحسوبية،وضمان توزيع عادل للدخل يشمل المناطق الجغرافية كافة،وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكلٍ كافٍ وملائم.
الآثار الاقتصادية والسياسية للديون والمنح
تستخدم الدول المانحة والدائنة سياسات الاستحواذ الناعم عبر العديد من الأدوات بما فيها المنح والديون،التي عادة ما يتم ربطها بمجموعة من الشروط، أهمها ضرورة تعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي والاجتماعي، واتباع سياسة اقتصادية معينة. ويتضح هذا بجلاء عبر اشتراط الحصول على ما يمكن تسميته بشهادة حُسن سلوك من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
تؤدي المديونية عادةً إلى تراكم الأعباء والالتزامات على الدول المدِينة، مما لا يمكّنها من انتهاج سياسات اقتصادية ستقلة،كما يكبح الجهود التي تُبذل لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص إمكانية تقديم خدمات ملائمة للمواطنين. ومن أخطر ما يمكن الإنجرار إليه هو تمويل النفقات الجارية، وخاصة الرواتب من خلال الديون. وهذا ما وصلنا إليه في الأردن خلال السنوات الأخيرة، ونتيجته أن تصبح الديون مجرد استهلاك بدل أن يتم استخدامها لإقامة مشاريع تنموية.
كما أن الاستمرار في الاستدانة يؤدي إلى تدني التصنيف الائتماني، وبالتالي رفع اسعار الفائدة، مما ينعكس بمزيدٍ من أعباء خدمة المديونية.وفي حالة الأردن نجد أن خدمة الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من (2،5 %) عام 2013 إلى (6 %) عام 2016 ،وبلغت ( 5،2 %) في نهاية الربع الثالث من عام 2018.
ذلك يعني أن نسبة خدمة الدين الخارجي من الناتج تقارب أو تزيد على ضعف نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أيضاً أن هناك ضغطاً واضحاً على احتياطيات العملة الأجنبية،خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة خدمة الدين الخارجي تتراوح بين (6 %) لى (17 %) من الصادرات.
وفي حال استمرَّت التطورات في هذا الاتجاه، فقد تؤدي إلىتراجع الادخار المحلي، ومن ثم تراجع الاستثمارات وغيرها من الآثار الاقتصادية.وبالرغم من أن هناك مَن قد يعتقد أن الديون الداخلية متاحة دون قيود فهو خاطىء لأن أثرها يظهر سريعاً على أسعار الفائدة المحلية وعلى الاستثمار .
آفاق الخروج من المديونية
يخضع مفهوم اَفاق الخروج من المديونية للعديد من الاجتهادات ويثير الكثير من التساؤلات.فهل المطلوب الاستغناء عن الاستدانة،أي بكلمات أخرى الوصول إلى موازنة متوازنة،أو موازنة بفائض، أم إن المقصود هو تخفيض الدين بوصفه رقماً مطلقاً، أو تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو تخفيض كلفة خدمة الدين ؟ ولكي لا نبتعد كثيراً ونطرح أهدافاً غير واقعية وغير قابلة للتحقيق،فإن أقصى ما يستطيع الأردن التفكير فيه هو تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي عبر تخفيض نسبة نموّ الدين لتكون أقل من نسبة نمو الناتج،إضافة إلى تخفيض عبء خدمة المديونية عبر الإدارة الجيدة والحصيفة للدين العام، من خلال إعادة التفكير في هيكل المديونية وغايات استخداماتها.
إن الخروج من هذا الواقع المتمثل بارتفاع نسبة المديونية وارتفاع كلفة خدمتها،يستلزم رفع نِسب النمو الاقتصادي، كما يتطلب ذلك أن يكون لدينا التصور الواضح المدروس للمدى الزمني الذي يستغرقه هذا الأمر، فضلاًعن الخروج بأفكار إبداعية جديدة على مختلف المستويات،ومعالجة التشوّهات الاقتصادية التي نعاني منها.
تعتبر الظروف الإقليمية إحدى المؤثرات الأساسية على الاقتصاد الأردني، لكن من الواضح أن الفترة القادمة ستشهد تحولاً نحو الأفضل. وهذا التحول، وإنْ كانت تشوبه حالة من عدم اليقين، إلا أن الآثار المتوقعة ستكون إيجابية إلى حدّ معقول؛ ففتح الأسواق من جديد أمام السلع الأردنية، وإعادة بناء جسور التعاون مع الدول المجاورة، والتخفيف من عبء استضافة اللاجئين، وعودة الاستقرار في الجوار،كل ذلك يبعث على التفاؤل بقادم أفضل، ويرتب علينا أيضاً مسؤولية أكبر للاستفادة من الفرص المتاحة،فإعادة الإعمار تحمل في طياتها مشاريع استثمارية ضخمة، وحاجة لخدمات القوى البشرية، وغيرها،وهذا بحد ذاته يعتبر سبباً إضافياً لإعادة النظر في أسلوب إدارة الملفات الاقتصادية، وخاصة العلاقة مع القطاع الخاص الذي يُفترَض أن يتولّى مهاماً أساسية في القضايا المتعلقة بتحفيز الاستثمارات واجتذابها، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل أن يكون قادراً على اغتنام الفرص التي قد تصبح متاحة في وقت قريب.ويتطلب إعادة النظر في أسلوب إدارة الملفات الاقتصادية،الذي لا يتم بسهولة،إرادة وكفاءة وقدرة على التعاطي مع المستجدات تستند الى رؤية شاملة.
ولا بد للمحاولات التي تبذلها المملكة حالياً في سبيل خفض نسبة الدين العام وتقليص كلفة خدمته من خلال الإجراءات الضريبية،من أن تتعزَّز من خلال الاعتراف بجذور المشكلة المتمثلة في انخفاض معدل النمو وحجم الإنفاق العام،وهو أمريقودنا مباشرة إلى ضرورة الاعتراف بضخامة حجم القطاع العام وتجاوزه النسب العالمية المتعارف عليها.
ومن باب الإنصاف لا بد من الاعتراف بأن بعض القرارات الإدارية أسهمت في تشجيع التوجه نحو العمل في القطاع العام،خصوصاً مع رفع رواتب العاملين في هذا القطاع لتصبح نسبتها أعلى مما هي عليه في القطاع الخاص. كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن عدم مساهمة القطاع الخاص في توليد فرص عمل كافية يفاقم هذه المعضلة.وهذا يقودنا مرة أخرى باتجاه تأكيد ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة القادرة على احتضان الاستثمارات وتوطينها،والتي بدورها توجد فرصاً للعمل تغطي الأثر الذي قد يتركه تراجع التوظيف في القطاع العام.
وفي الإطار نفسه، ينبغي تأكيد التشجيع لاعتماد روح المبادرة لدى الشباب في إنشاء مشاريعهم الخاصة،مع تعزيز الدعم المقدم للمشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة.وفي ذات الإطار لا بد من إيلاء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهتماماً خاصاً لدورها في تعزيز النمو الاقتصادي وأثرها الإيجابي في تقليص الإنفاق العام.
إن رفع نسبة النمو الاقتصادي لا بد أن تكون بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص،الذي يقوم عملياً بدوره، لكنه بحاجة لبيئة وظروف مناسبة حتى يعطي ويزيد في الإنتاجية.ولكي تتوافر مقومات النجاح لتحفيز النمو، لا بد أن تتوافر البنية التشريعية الملائمة القادرة على تحفيز القطاع الخاص من أجل المشاركة الفاعلة،مما يقتضي إصلاحات ضريبية،إلى جانبإجراءات قد لا تكون مكلفة لكنها ضرورية وفعّالة، مثل مكافحة الفساد، والارتقاء بمستوى إنتاجية القطاع العام عبر رفع كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته،وترسيخ مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة،وبناء ثقافة مؤسسية تستند إلى مفهوم الخدمة وأخلاقيات العمل.
إن الإنجازات تتحقق عادةً من خلال الإدارة الجيدة وجدية التنفيذ، والقدرة على ترجمة الخطط إلى برامج عمل وإجراءات محددة ومحكومة بفترات زمنية ومؤشرات أداء،وفوق ذلك المتابعة الحثيثة لما يتم إنجازه من أعمال،مع التطبيق العلمي والعملي لمبادىء المحاسبة والمساءلة والحكم الرشيد والإدارة النزيهة.وكثيراً ما يتشكَّل الفرق بين الفشل والنجاح من خلال القدرة على استغلال المزايا المتاحة في التغلب على القيود والمحددات وتحويل التحديات إلى فرص نجاح.
وزير مالية أسبق