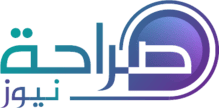صراحة نيوز – بقلم الدكتور جواد العناني والدكتور ابراهيم بدران
(1)
مع جائحة كورونا، تمر المنطقة العربية بفترة غير مسبوقة من التراجع والتفكك وعدم الاستقرار، وانهيار دول واستباحتها من القوى الخارجية الإقليمية والدولية، إضافة إلى الخروج الجماعي على القانون والدولة، وانفلات المنظمات الإرهابية، واشتداد الانقسامات الدينية والمذهبية والطائفية والقومية، وتكاثر الحركات المتطرّفة، وتفتت الكتلة العربية، وغياب الرأي العربي المتوافق عليه، سواء للدول أو منظمات المجتمع المدني أو النخبة من المفكرين والسياسيين، وفوق ذلك تبعثر الرأي الوطني وضياع البوصلة السياسية والاقتصادية في معظم أقطار المنطقة. وكان نصيب المنطقة من اللاجئين والنازحين نتيجة ذلك كبيراً، بحيث تجاوزت أعدادهم في بعض الأقطار أكثر من 30% من السكان، بكل الضغوط على الاقتصاد والموارد والأرض والبيئة والمجتمع والمواطن. يضاف إلى ذلك تغوّل إسرائيل على الشعب والأراضي الفلسطينية والأماكن المقدسة والإمعان في تثبيت عنصريتها وأطماعها التوسعية في الاقطار العربية المجاورة وغير المجاورة، وذلك كله بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.
تبيّن مجريات الأحداث في المنطقة، بما فيها جائحة كورونا، بوضوح، أن فترة عدم الاستقرار والصراعات المذهبية والسياسية والتدخلات الأجنبية والاعتداءات الإسرائيلية سوف تستمر عدة سنوات. ويختلط في الصراعات الدائرة في المنطقة السياسي بالاقتصادي بالإجتماعي بالفكري بالديني بالإعلامي بالدعاوي بالمخابراتي بالتطرّف بالإرهاب، بأطراف غير محدّدة الهوية وأخرى متسترة الغايات والأهداف. وهذا كله يجعل من الممكن للقوى المتطرّفة أن تتسرّب إلى جسم المجتمع الوطني، وخصوصا فئة الشباب. وجاءت جائحة كورونا لتزيد المشكلات العربية تفاقماً، وقد تستمر الجائحة سنة أو سنتين، حتى يتم تطوير لقاح مضادٍّ لها، بكل ما يرافق ذلك من تداعياتٍ صحيةٍ واقتصادية و اجتماعية مخيفة . الأمر الذي يتطلب خططا وطنيةً تقوم على رؤيةٍ شموليةٍ تعمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية وقادة الفكر والعلم على تنفيذها فوراً ولفترة كافية.
وفي مثل هذه الظروف، حين تشتد الأزمات وتتفاقم المشكلات، فإن الأنظار تتجه نحو المفكرين المتميزين اصحاب الرؤية الاستشرافية المستقبلية. وفي مقدمة هؤلاء لدينا سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء منتدى الفكر العربي، والذي له، ومنذ عدة عقود، مساهماته الدولية والعربية والوطنية الفكرية والإنسانية المرموقة. ومن ضمن ذلك ما وجّه به، قبل سنوات قليلة، بإعداد ميثاقين عربيين، اجتماعي عربي واقتصادي عربي. وكان لنا الشرف، نحن كاتبا هذا المقال، في صياغة النسخة النهائية للميثاق الاقتصادي العربي، والذي أقرّته بالإجماع الهيئة العامة للمنتدى عام 2015، وبعد عدد من جلسات البحث والنقاش شارك فيها مفكّرون عديدون.
(2)
وباستجابة كريمة من سمو الأمير الحسن بن طلال، عندما التقى به وزراء ومثقفون عرب، واقترحوا إنشاء منتدى ليكون جسراً رابطاً بين السياسيين وصناع القرار في الوطن العربي من ناحية، وبين المفكرين العرب أنفسهم من ناحية أخرى، فتأسس منتدى الفكر العربي عام 1980، بعد انعقاد القمة العربية الاقتصادية في عمّان، وسيحتفل قريبا بعيده الأربعين. وابتدأ المنتدى سنواته الأولى بعزيمة عالية، وقدّم أبحاثاً وكتباً وعقد ندوات ومؤتمرات، و تواصل مع المنتديات الشبيهة في الوطن العربي، والصين، وتركيا، وأوروبا، والهند، وباكستان، وصار قبلة للباحثين، لا يشوب عمله خلاف. وكثر المفكرون العرب الراغبون في عضويته، وصارت عملية الانتقاء والاختيار ضرورية. واجتمعت فيه من كل الوطن العربي مجموعة من العقول النيّرة، تقبل الخلاف وتبحث عن الجوامع، وتعي ضرورة تحصين القرارات الحكومية بالفكر والعلم والتمحيص. وعلى الرغم مما مرَّ على الأمة من أحداث وتحدّيات، بدأت بإنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981، ومجلس التعاون العربي عام 1986، واحتلال العراق الكويت عام 1990، الواقعة التي شكلت صدمة عنيفة ونكسة قاتلة، وعكست الخلافات بين المفكرين العرب، بدلاً من أن تجعله نقطة جمع ومصالحة. بعد ذلك جاء الربيع العربي، والخلافات العربية العربية. على الرغم من ذلك بقي المنتدى قائماً وفاعلا، وهناك مفكّرون كثيرون ما يزالون يرون فيه منبراً لتجسير الخلافات العربية. وفي عام 2012، أنهى منتدى الفكر العربي وضع “ميثاق اجتماعي عربي”، نتحدث عنه في مقالة قادمة. وفي ظل الأزمة الإقتصادية التي فاقمتها جائحة كورونا، نركز هنا على الميثاق الاقتصادي العربي.
ما الذي يجعل هذا الميثاق مختلفا عن غيره مما أنتجته جامعة الدول العربية؟، أو ما الذي استجد في الظرف العربي كي يبرّر الحاجة الماسّة إلى الرجوع إليه؟ أو إعادة النظر في الفرضيات الأساسية التي قامت عليها دراسات مهمة أقرّت في مؤتمر قمة عمان (نوفمبر/ تشرين الثاني 1980) ، وساهم في إعدادها أعضاء منتدى الفكر العربي قبل الإعلان عن تأسيسه؟. ونخص بالذكر وثيقتي “استراتيجية التنمية العربية” و”عقد التنمية العربية”. وقد وضعت هاتان الوثيقتان بعد ارتفاع أسعار النفط، ودخول العالم في ظاهرة “الكساء التضخمي”، وانقسام الوطن العربي إلى ثنائيات دول مصدّرة للنفط أو مستوردة له، أو دول تتمتع بفائض رأس مال وأخرى لديها فائض عمالة، أو دول مصدّرة لرأس المال وأخرى مصدّرة للعمالة.
ومنذ الازمة المالية العالمية عام 2008، تأكد بشكلٍ لا يقبل الجدل فيه أن الاقتصادات العربية مرهونة ومرتبطة بالاقتصاد الدولي، والأميركي منه خصوصا، وقد أدت ظروف الاستثمار الخليجية إلى تصفية استثماراتٍ كثيرة في الدول العربية الأخرى. وشاهدنا تراجعاً في التوظيف العربي لحساب الإثنيات الآسيوية في مجلات المال والمصارف والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والبناء، والنقل، والطيران، وغيرها.
وبعد انفجار أزمة فيروس كورونا المتجدّد، وهبوط أسعار النفط، بدا النظام العربي برمته مجزّءاً ومشرذماً. وتعززت ظواهر خطيرة، في مقدمتها فقدان العرب دورهم السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط (حتى الآن على الأقل) لصالح ثلاث دول أو أربع مجاورة، تركيا وإيران وإسرائيل، وحالياً تسعى إثيوبيا إلى أن تكون رابعتها. عزّز هذا ضرورة العودة إلى “الميثاق الاقتصادي العربي”، والذي قال فيه الأمير الحسن في حفل إعلانه: “الميثاق الاقتصادي العربي … يشكل مدخلاً تحليليا للواقع التنموي في الوطن العربي وآفاقه المستقبلية… وتركّز أسباب ومبررات الميثاق على ضرورة وصول القرار الاقتصادي العربي الوطني والمشترك إلى عقلانية مستقرّة تتجنب السياسية ومنعطفاتها، وتحافظ على استقرارية الإنجاز الاقتصادي وديمومته”. في حين ركّز جواد العناني، في كلمته بتلك المناسبة، على “أن الفوارق الاقتصادية بين الأقطار العربية لا تلغي تشابه التحدّيات داخل الأقطار نفسها، مثل البطالة، والمستقبل الرقمي، والفقر، والريعية، واتساع قطاع الحكومة، وضعف إدارة الموارد في الدول”، بينما أكد إبراهيم بدران في المناسبة نفسها على “إن على الأقطار العربية أن تكون على يقين راسخ بأن التحوّل إلى الاقتصاد الصناعي الاجتماعي هو حجر الزاوية لاستمرار الدول الوطنية منفردة، والدول العربية مجتمعة، ولتكون جزءاً فاعلاً من الحضارة الإنسانية، لا مستهلكة لإنتاجها”.
يشتمل الجزء الاول من الميثاق على وصف الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي. ويوضح أن التشابه في التحدّيات الاقتصادية التي تواجه الأقطار العربية صار كبيراً لا تخطئه العين، ولا يغيب عن ذهن المتبحّر في الأمور، فلم تعد الازدواجيات التي كان يوصف بها الوطن العربي صحيحةً تماماً، فالتقارير الصادرة عن المنظمات العربية المشتركة ما عادت تقسّم الوطن العربي إلى دول مصدّرة للنفط وأخرى مستوردة له، ولا دول فائض رأس المال مقابل دول ذات فائض في القوة البشرية.
وفي ظل ظروف جائحة كورونا، يشكّل الميثاق الإقتصادي العربي خريطة طريق ومسارا أسلم لمواجهة تداعيات المستقبل، ولضمان التنمية المستدامة، وللحفاظ على الأمن والاستقرار، وإضفاء الشرعية والوطنية على نظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
(3)
تعاني جميع الأقطار العربية، بما فيها النفطية، من هشاشة البنية الاقتصادية، وأزمات عميقة في المياه والطاقة وإنتاج الغذاء وتهميش الزراعة وعدم إنشاء مراكز اقتصادية قوية في الأرياف والأطراف، وهلامية سوق العمل، وتراجع الثقافة والفنون، إضافة إلى أزمات تداول السلطة وغياب الديموقراطية والانفراد في القرار وضعف الحياة الحزبية أو غيابها، والاعتماد المفرط على القوى الأجنبية، وضعف الإنتاج المحلي والإفراط في الاستيراد. وكذلك انتشار الفساد والمحسوبية في الإدارات المختلفة. كما تعاني المنطقة من غياب التعاون المستقر والمتنامي بين أقطارها، حتى المتجاورة منها، وغياب شبكات السكة الحديدية والكهرباء والصناعات الكبيرة المشتركة ومراكز الأبحاث والتطوير. وقد استنزفت الحروب الأهلية والانقسامات قوى بعض البلدان، وهمشت التعاون العربي، وأنتجت نخبا سياسية لا تزال تتمسك بالسلطة بأي ثمن. وتضم المنطقة العربية 420 مليون نسمة تعاني من نسبة بطالة مرتفعة كانت 15.7% قبل الجائحة، وهي ضعف المتوسط العالمي للبطالة قبل كورونا، والتي كانت في حدود 7.9%. وبحلول كورونا، ارتفعت نسبة البطالة، وخصوصا لدى العمالة غير المنظمة، والتي تشكل 52% من مجمل العمالة أو حوالي 47 مليون إنسان موزّعة في مختلف البلاد العربية. وترتفع البطالة بين الإناث عنها بين الذكور، وبين حملة الشهادات الجامعية عنها بين المستوى الأدنى من التعليم. وتختلف نسبة الفقر من بلد إلى آخر اختلافاً كبيراً، فهي الأعلى في بلدان كالسودان واليمن واريتريا و الأدنى في الدول النفطية. ويبلغ متوسط السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 17%، وترتفع هذه النسبة بدرجة كبيرة في الأرياف والأطراف وبؤر الفقر في المدن.
كما تعاني جميع الدول العربية من تآكل الطبقة الوسطى، وتراجع التعليم في جانبه النوعي على الرغم من التوسع الكمي، حيث تجاوزت أعداد الطلبة الجامعيين أربعة ملايين طالب، كما تعاني الأرياف والأطراف من الإهمال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. يتراوح متوسط دخل الفرد في المنطقة من 69 ألف للفرد في قطر نزولاً إلى 38 ألف في الإمارات و30 ألف في الكويت و23 ألف في السعودية و 4.4 ألف في الأردن و4 آلاف في الجزائر و3.3 في المغرب وتونس و3 آلاف في مصر نزولاً إلى 0.7 ألف في السودان، وبالتالي فإن المتوسط العربي العام في حدود 3500 دولار للفرد سنوياً. وتعاني الأقطار العربية من الاعتماد المفرط على الخارج، سواء في المديونية أو الغذاء أو الدفاع. كما أن الإفراط في العمالة المهاجرة أحدث خلخلة كبيرة في بنيان هرم المهارات، إضافة إلى هجرة العقول، بسبب الضغوط وانعدام الفرص.
(4)
ستخرج جميع دول العالم من كورونا، وهي في تراجع اقتصادي وإنهاك اجتماعي وبطالة مرتفعة وتعطل للخدمات وتباطؤ في التعليم والثقافة، وإنهاك للأجهزة الصحية من مرافق ومؤسسات وكوادر بشرية، وسيكون وضع الأقطار العربية أشد صعوبة وخطورة، بسبب الاعتماد الكبير على الآخرين. وهنا يجب التفكير في الخروج من الأزمة ليس بهدف العودة إلى حالة ما قبل كورونا. ولكن إلى حالة جديدة سارعت في تشكيلها أزمة كورونا نفسها، ومنتجات الثورة الصناعية الرابعة من انتشار العمل عن بعد، وتوزيع المنتجات بالتسليم delivery، ولجوء صناعات وخدمات كثيرة إلى استخدام الروبوطات والأنظمة الذكية، الأمر الذي سيؤدي إلى اختفاء وظائف كثيرة، قد تصل إلى 30% أو 40% من الوظائف المعروفة اليوم، ما يجعل أزمة البطالة بالغة التعقيد، إذا لم يتم تطبيق البرامج المناسبة. وهكذا، المطلوب التفكير في فضاءات رئيسية: الصحي، الغذائي، الاقتصادي، الاجتماعي، التعليمي والثقافي، السياسي.
(5)
من دون المبالغة في التقدير، لدى جميع الأقطار العربية إمكانات بشرية بالدرجة الأولى، وطبيعية يمكن أن تكون مدخلاً لحركة نهضة اقتصادية اجتماعية إذا توفرت الإرادة والإدارة وثقة الشعوب بما تفعله الإدارات. كما أن لدى أقطار كثيرة ثروات كبيرة موزّعة ومشتتة بين الأفراد والمؤسسات، من دون أن تجد الفرصة المناسبة للاستثمار. كما أن في كل بلد عربي مجموعة من الصناعات الكبيرة والقطاعات الخدمية الجيدة التي يمكن أن تكون قاطرة لنهضة اقتصادية اجتماعية متنامية. وفي الجانب السياسي، الشعوب العربية، بدون استثناء، توّاقة إلى إدارات كفؤة ونزيهة بعيدة عن الفئوية والمناطقية، وإلى تعزيز ولائها للوطن، من دون اعتبار البقاء في السلطة الحافز الوحيد لها، وهذا ما تطالب به الجماهير.
الخروج من الازمة الراهنة في جوانبها المختلفة يتطلب العمل في مسارين: الوطني والعربي.
في المسار العربي: على جامعة الدول العربية أن تبادر إلى تفعيل منظمات العمل العربي المشترك بروح جديدة، تتمركز حول إدراك الأخطار المحيطة بالجميع. دعوة قادة الدول العربية إلى لقاء عن بعد يتم فيه: التعهد بتجميد الخلافات البينية خمس سنوات، أو الانتهاء منها على مبدأ منتصف الطريق. البدء في التعاون في مشاريع ليست محل نزاع او ليست ذات طابع سياسي، وفي مقدمتها مراكز ابحاث للطاقة المتجدّدة، تحلية المياه بالطاقة الشمسية، إنتاج الغذاء، الزراعة الذكية، مركز أبحاث الأوبئة. التوقف عن التطبيع المجاني والالتزام بخطة السلام العربية فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.
(6)
في الفضاء الصحي، لا بد أن تستمر الجهود للسيطرة على جائحة كورونا بالوسائل الإدارية والقانونية والصحية والتكنولوجية من حيث استخدام الأجهزة والمعدات التي تحقق مفهوم التباعد والتعقيم والفحص المبكر. كما يتطلب الأمر وضع ضوابط لوجستية للأشخاص أو البضائع، بحيث لا يدخل البلاد إلا من يخضع للحجر الصحي الصارم، وعند الحدود، في حين يتم استخدام النقل التبادلي لنقل البضائع، بما فيها الترانزيت، فكل بضاعةٍ يقف ناقلوها عند الحدود من دون الدخول ليتسلم البضاعة بعد تعقيمها ناقلٌ وطنيٌّ، يوصلها إلى النقطة المطلوبة في البلاد أو عند الحدود وهكذا.
أصبح احتمال ظهور أوبئة جديدة بشكل مفاجئ متوقعاً. ومن هنا، لا بد من إنشاء مركز وطني للأوبئة، بشكل مستقل أو بالتعاون ما بين أكثر من طرف. وتشارك جامعتان أو أكثر لدعم الأبحاث التي يقوم بها أو يتطلبها المركز. ويتطلب الأمر كذلك تكثيف الجهود في الصحة المجتمعية، وخصوصا في الأرياف والمناطق الفقيرة، وتكثيف التوعية الصحية بأساليب مبسّطة. ويضاف إلى ذلك دعم الصناعات الطبية والدوائية، وإنشاء صناعات وطنية قوية بمساهمة الصناديق الحكومية للأجهزة الطبية الأكثر احتياجاً في حالة الأوبئة.
وفي الفضاء الغذائي، أظهرت جائحة كورونا، ما رافقها من توقف الاستيراد والتصدير إلا في أضيق الحدود، أن العامل المكمل للصحة هو الغذاء، وخصوصا إذا طالت فترة التباعد وتوقف الإنتاج بأشكاله المختلفة. ويعاني العالم العربي من عجز غذائي متفاقم قد يصل إلى 53 مليار دولار لعام 2020، أو ما يقرب من 130 دولار لكل فرد سنوياً. و يتركّز العجز في الأساسيات، كالقمح والذرة والحبوب والبقوليات والزيوت النباتية واللحوم، والتي هي مصدر الغذاء الرئيسي والبروتينات للشرائح الوسطى والفقيرة من المجتمع. والأرقام هذه مرشّحة للزيادة، نتيجة التغيرات المناخية والتصحر وشحّ المياه. وهذا يتطلب أن تضع الدولة برنامجاً وطنياً للأمن الغذائي، يقوم على التوسع في الإنتاج الزراعي، وخصوصا الأساسيات، وبأساليب حديثة ومتطوّرة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي تتطلب كمياتٍ أقل من المياه، ابتداء من الزراعة المائية وانتهاء بالسلالات عالية التحمّل للحرارة. ومن غير الممكن أن يتحقق الأمن الغذائي من دون تحقق الأمن المائي الذي يقتضي التوسع بتحلية المياه بالطاقة الشمسية. وهنا يمكن إنشاء مركز ابحاث عربي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، ومركز وطني لتطوير الزراعة والنهوض بالتكنولوجيا الزراعية على أوسع نطاق.
(7)
وفي الفضاء الاقتصادي، وبالرجوع إلى الميثاق الإقتصادي العربي، نجد أنه ليس لدى أي دولة عربية برنامج استراتيجي شامل للاعتماد على الذات، وللتحول والانتقال من اقتصاد الريع أو التجارة أو استخراج الثروات الطبيعية أو صناعة المال إلى حالة الدولة الصناعية ذات الاقتصاد الصناعي الذي يعتمد على مدخلات العلم والتكنولوجيا والإنتاج السلعي والخدمي المتقدّم.
كان من المتوقع، وبالاستفادة من تجارب دول شرق آسيا، أن يكون هناك شعور سياسي وفكري بصدمة التخلف، ومن ثم أن يكون هناك انتباه، ثم تركيز أكثر على تصنيع الاقتصاد الوطني وإنتاج السلع والخدمات على مستوى القطر الواحد. إلا أن ما تم عكس ذلك، حيث ضعُف الإنتاج السلعي، واستمر الاعتماد المتزايد على الاستيراد، إلى الدرجة التي أوقفت بعض الدول العربية إنتاجها التقليدي من السلع الصناعية والزراعية، لتستورد البديل من السوق العالمي، بما في ذلك الغذاء، هذا إضافة إلى الاعتماد المفرط على القروض والمساعدات المالية والعلمية والتكنولوجية.
يشهد العالم تحولات اقتصادية ومالية وتكنولوجية وبيئية عميقة، سوف تتراجع فيها فرص الاقتراض والمساعدات، وسوف تتعقد متطلبات الحفاظ على الاستقلال السياسي والأمن الاجتماعي، من دون وجود اقتصاد وطني حديث قادر على التعامل مع المتطلبات الوطنية بمختلف أشكالها، ومستعد للتفاعل مع العالم من موقف القوة والإنتاج، وليس الضعف والاستيراد، وهذا يتطلب من كل دولة بذاتها وبمفردها ومسؤوليتها.
أولاً: أن يترسّخ الإدراك والايمان لدى قيادات الدولة الوطنية وقواها، من أحزاب ومفكرين، أن اقتصادات الدول لا تُصنع في الخارج، ولا تقوم على المنح والمعونات والقروض، ولا يجدي فيها التطبيع مع إسرائيل، وإنما استثمار رأس المال البشري والثروة الوطنية التي يملكها صغار المدّخرين والمؤسسات الوطنية، من خلال مفاهيم الاعتماد على الذات، والتحول نحو الإقتصاد الصناعي الإجتماعي.
ثانيا: الاقتصادات القادرة على الاستمرار والتكيف والتنامي في الاقتصادات الصناعية الانتاجية التي تعظم مدخلات العلم والتكنولوجيا والمعرفة في إنتاجها لكل القطاعات السلعية والخدمية والمعلوماتية.
ثالثاً: ان مناطق مختلفة من العالم، ومنها المنطقة العربية، معرّضة لعواصف التغيرات المناخية، والتي قد ترافقها أوبئة غير معروفة، تشمل الإنسان والنبات والحيوان، الأمر الذي يتطلب برنامجاً وطنياً للدولة، يضمن نسبة مقبولة من الاكتفاء الذاتي، وخصوصا في البحث العلمي التطبيقي، وفي الغذاء والدواء.
رابعاً: على الدولة أن تضع، من خلال الخبراء، برنامجاً وطنياً لتصنيع الاقتصاد الوطني، والانتقال المبرمج خلال عشر سنوات من الاقتصادات الريعية إلى الاقتصاد الانتاجي التكنولوجي، بما في ذلك الزراعة والمياه والطاقة والنقل. وتصلح تجربة دول شرق آسيا، وخصوصا ماليزيا وتايوان وسنغافورة وكوريا، أي منها، مع التعديل، لمختلف الدول العربية.
خامسا: لا يجوز للدولة أن تنسحب من العمل الاقتصادي، أو أن تركز على الجانب المالي فقط، بل عليها أن تقيم علاقة شراكةٍ حقيقيةٍ، وليست شكلية أو تزيينية مع القطاع الخاص، سواء في أعماله القائمة أو الأعمال المستقبلية، والنماذج في اليابان وماليزيا مفيدة للغاية.
سادساً: نظراً لاتساع مساحات الفقر والجوع وتآكل الطبقة الوسطى، وهي رافعة النهوض الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، فإن على الدولة أن تتوسع في تشجيع الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والاستثمار والوقفيات الدائمة، ليكونوا شركاء في إنشاء المشاريع الجديدة، وخصوصا في الأرياف والأطراف، وذلك كله على طريق الاقتصاد الاجتماعي.
سابعاً: وضع سقوف عليا معلنة لمجموع الرواتب والمكافآت والبدلات والتقاعدات التي يتحصل عليها الموظف العمومي في أثناء عمله أو تقاعده، بحيث لا يتجاوز السقف خمسة عشر أمثال متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتحويل الفروق إلى صناديق استثمارية تهتم بإنشاء مشاريع إنتاجية في الأرياف أو المناطق الفقيرة.
ثامناً: وضع برنامج مدته خمس سنوات لتقليص النفقات الحكومة بنسبة 5% سنوياً، وتقليص الجهاز الحكومي، بحيث لا يتجاوز نسبة القوى العاملة مع الحكومة 20% من مجمل القوى العاملة. وتحويل الأموال المتوفرة عن هذا التقليص لتمويل برامج وطنية طويلة الأمد (15 – 20 سنة)، تهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على البيئة الطبيعية من خلال السدود والبحيرات الاصطناعية وتكنولوجيا الاستمطار وتحلية المياه بالطاقة الشمسية وتوليد المياه من الهواء وإنشاء الغابات وتشجير المناطق الجرداء.
تاسعاً: سوف يشهد العالم توسعاً كبيراً في العمل عن بعد، وفي إختفاء وظائف كثيرة، ما يجعل الإهتمام بالريادية لتصبح ثقافتها ومهاراتها جزءا أساسيا من مناهج التعليم في مراحله المختلفة. والإهتمام بالرياديين والمبدعين ضرورة حتمية لتوسع الهيكل الإقتصادي، ومواجهة البطالة والخروج من الدولة الريعية. وهذا يعطي فرصا جديدة للصناعات المنزلية أو الفردية القائمة أو التي سوف تُستحدث. وعليه، لابد من إنشاء مؤسسة متخصصة على مستوى المحافظة، تتولى التطوير التكنولوجي والهندسي للصناعات المنزلية والفردية، كما تتولى تسويق هذه المنتجات على المستويين، الوطني والدولي.
عاشراً: وضع قائمة تصاعدية بالمستوردات، تمهيداً للبدء في إنتاج السلع والخدمات الأقل تعقيداً والتصاعد التدريجي في التصنيع، حتى الوصول إلى مستوىً مقبول من الاعتماد الذاتي.
حادي عشر: تخفيض فروق الفائدة بين الإيداع والاقتراض إلى ما لا يزيد عن 3.5%، وإنشاء بنك للتنمية الصناعية، وآخر “للتنمية والمكننة الزراعية، وتقديم القروض الميسّرة للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ثاني عشر: وضع برنامج من خلال الخبراء لتكون الصناعات والمشاريع الكبرى القائمة قاطرةً لمشاريع إنتاجية جديدة تغطي احتياجاتها من “الصناعات القبلية والبعدية” والمتفرقة، وتكون الدولة شريكاً في الصناعات الكبيرة الجديدة.
ثالث عشر: تصحيح الأخطاء التي وقعت في برامج الخصخصة، من خلال استعادة ملكيتها لشركات مساهمة عامة وطنية.
رابع عشر: إنشاء المجلس الوطني “للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات”، يكون أعضاؤه من الشركات التي يزيد رأسمالها عن 2.5 مليون دولار، إضافة إلى ممثلين متطوعين من الحكومة والخبراء، يتولى المجلس توجيه مخصّصات المسؤولية المجتمعية للشركات، لإقامة المشاريع الأكثر ضرورةً واستعجالاً، ويكون الهدف هو إحداث تأثير تراكمي لهذه المخصصات، بدلاً من أن تنفق من دون برمجة، ما يجعل أثرها الاجتماعي الاقتصادي ضئيلاً للغاية.
خامس عشر: إنشاء مجلس اقتصادي في كل محافظة، يتشارك فيه القطاع الخاص والرسمي والجامعات الموجودة في المحافظة، يتولى دراسة إمكانات المحافظة، ووضع خطط وبرامج اقتصادية لها.
سادس عشر: وضع مدونة سلوك لمجالس إدارة الشركات والمؤسسات المستقلة.
سابع عشر: إصدار قوانين تنص على تغليظ عقوبة الرشوة والفساد القبلي والبعدي والنقدي والعيني، بما في ذلك التوظيف اللاحق، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وتجارة المخدّرات ونقلها وترويجها، لتكون عدة أضعاف من العقوبات الحالية حدّا أدنى.
ثامن عشر: إصدار “وثيقة المصالحة والعودة”، يتم فيها إتاحة الفرصة للملاحقين بقضايا فساد للإسراع بتسديد 75% من الأموال المطالبين بها، أو التي اختلسوها خلال ستة أشهر في مقابل التوقف عن ملاحقتهم وإسقاط القضايا وبدء صفحة جديدة.
وفي فضاء التصنيع، لا بد من تأكيد أن لا تقدم ولا نهوض اقتصاديا حقيقيا ولا مواجهة للبطالة ولا إعمار للأطراف والأرياف، من دون مشاركة المرأة في العمل الإقتصادي الحديث، ووضع برنامج وطني لرفع نسبة مساهمة المرأة في قوى العمل إلى ضعف مستواها الحالي بحلول عام 2030. من شأن دخول البلاد في برنامج تصنيع شامل يقوم على التكنولوجيا المتقدمة التي أدخلتها الثورة الصناعية الرابعة، مثل الروبوطية والأوتوماتيكية والذكاء الاصطناعي، أن يشجع انخراط المرأة في كل الأعمال التي تتطلب المبادرة والريادية والإبداع. هذا بطبيعة الحال من دون إهمال الصناعات الأساسية التي يرتكز عليها أي برنامج للتصنيع. ولعل تجربتي سنغافورة وإيرلندا يمكن الاستفادة منها بشكل موسع. وتتيح الأعداد الكبيرة نسبياً للمتعلمين من الشباب والفتيات الفرصة لاستثمار رأس المال البشري في التصنيع. ويتيح اهتمام الأجيال الصاعدة بالبرمجيات والحاسوبيات الفرصة لدخول التكنولوجيا المتقدمة وفق برنامج وطني في هذا الاتجاه. وهذا يتطلب إعادة النظر في علاقة الجامعات بالصناعة (بالمفهوم الشامل) في قطاعاتها المختلفة، وإعادة النظر في برامج التعليم والتدريب والتأهيل، ليتحول التدريب من التدريب المهني (بالمفهوم البسيط) إلى التدريب والتأهيل التكنولوجي. إذ ليس هناك اليوم من مهنة أو من عمل منتج أو قطاع اقتصادي في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات إلا ونجد للتكنولوجيا دوراً كبيراً فيها.
ينبغي أن تتحول أبحاث الاكاديميين في الجامعات ومراكز الأبحاث من البحوث النظرية إلى البحوث التجريبية والتطبيقية، كما فعلت دول شرق آسيا، وأن تتحول غاياتها من نشر البحوث لغايات الترقية إلى حل المشكلات التي تواجهها القطاعات المختلفة وتواجهها الدولة بكاملها. يشمل ذلك المساهمة في تطوير الصناعات وتعزيز مدخلات العلم والتكنولوجيا في الإنتاج وحل المشكلات التي تواجه الصناعات والزراعة والمساهمة في رفع الإنتاجية. ويكفي أن يُذكر هنا أن متوسط الإنتاجية في العالم العربي، سواء في الصناعة أو الزراعة، متواضعة تماماً، فالقيمة المضافة للزراعة تصل في مصر 5371 دولار لكل عامل سنوياً، مقابل 18000 في ماليزيا و46326 في ألمانيا و91547 في الكيان الصهيوني. ويعود هذا التباين الكبير إلى مدى استخدام التكنولوجيا المتقدّمة في الزراعة. التصنيع والتكنولوجيا المتقدّمة هما السبيلان الوحيدان لزيادة قيمة الإنتاج، سواء في الصناعة أو الزراعة، أو الخدمات أياً كانت.
(8)
وفي فضاء التعليم والثقافة، لا بد من التحوّل نحو العقل العلمي والتوجه المستقبلي والتعليم الذاتي والتفكير المتفاعل الناقد والإبداع في كل اتجاه، والارتقاء بالثقافة التي ترتفع بالمجتمع، ولا تهبط إلى أدنى مستوياته، وبالفنون وتذوق الجمال، إضافة إلى القيم الوطنية والإنسانية. ونشكل هذه بمجملها منظومة القوة الناعمة للمجتمع والعمود الفقري للرأسمال البشري الذي أصبح عماد التقدم. تتمثل نتاجات التعليم والتربية المطلوبة للنهوض في بناء العقل القادر على حل المشكلات، وتأصيل العقلية الرقمية، باعتبارها مدخل المستقبل والتفهم الواضح للقضايا المعاصرة ذات العلاقة. كما أن بناء الشخصية الوطنية والإنسانية يتطلب المراجعة، لتتحول إلى شخصية متفاعلة، تحب الإنتاج والريادة وصنع الأشياء والقادرة على المساهمة والمغامرة الاستكشاف والحريصة على انتمائها الوطني، من منظور الإبداع في المساهمة في بناء الوطن والقيم الإنسانية.
المعلم في المدرسة والأستاذ في الجامعة بحاجة إلى تدريب جديد في هذا الاتجاه، وكذا التدريب على إتقان التعليم عن بعد والتعليم المدمج. وتبقى مسألة أساسية تتمثل في القراءة والإطلاع والمتابعة، بعيداً عن السطحية والقفز على النقاط البارزة. وتتطلب هذه تأصيل القراءة منذ الطفولة، وتحسين اقتصاديات الكتاب والمادة العلمية المنشورة، حتى تصبح ضمن الإمكانات الاقتصادية للمواطن. تدريس الفلسفة وإعطاء الأهمية والوقت الكافي للفنون والرياضة والمغامرة والإستكشاف والريادية وصناعة الأشياء في التعليمين، الأساسي والعالي، كلها تمثل البوابة الحقيقية لتوجيه عقول الشباب نحو التعلم والتفكير والإبداع. وذلك كله من خلال بيئة تعليمية تفاعلية وصديقة ومعلمون وأساتذة يتطلعون إلى المستقبل بكل مستجدّاته، لا إلى الماضي بكل أحداثه وصفحاته.