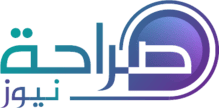صراحة نيوز – بقلم الدكتور ابراهيم بدران
صراحة نيوز – بقلم الدكتور ابراهيم بدران
(1) الدولة العربية
مرت المنطقة العربية بمساحتها الشاسعة وعلى مدى القرون الماضية في حالات متقلبة من حيث الحكم والدولة. ولكن السمة البارزة هنا تتمثل في نقطتين: الأولى: الحكم والسلطة. والثانية : بناء الدولة ذلك أن المنطقة بأصقاعها المختلفة كان يحكمها أشخاص ومن قوى أو جماعات أو فئات أو شخصيات غير عربية (السلاجقة، الطولونيون، الاخشيديون، البرامكة، المماليك… الخ) لدرجة أنه حين تولى جمال عبد الناصر رئاسة مصر أشار الكثير من المؤرخين إلى أنه يمثل أول “مصري” يتولى السلطة في مصر منذ زمن الهكسوس. وما ينطبق على مصر ينسحب على كثير من الأقطار العربية. وقد سبق وأن أشار ابن خلدون في مقدمته إلى استبعاد العرب من الحكم وإسقاطهم من سجل الجند منذ زمن المعتصم. ولذا تنامى لديهم تطلع قوي إلى الحكم والسلطة. وهم يرون الأجانب يحكمون ويتحكمون ابتداء من الموالي وانتهاء بالولاة. وإذا استثنينا العهود القديمة تماماً فإن معظم المناطق (أو الأقطار المعاصرة) لم يتم فيها بناء الدولة على أسس واضحة أي بمفهوم الدولة على أنه يمثل كياناً متماسكاً محدداً ومستمداً من الأرض والمجتمع وسلطة الادارة. وان كانت هناك مناطق أو أقطار ظهرت فيها حضارة ومنجزات ثقافية متميزة، ولكنها في الجوهر كانت مناطق للحكم والسلطة بشكل أو بآخر حتى سقوط الدولة العثمانية . كل ذلك وغيره جعل ثقافة بناء الدولة وعقلية التأسيس والتماسك والتفاعل المجتمعي للدولة أمراً غائباً إلى حد كبير في الثقافة العربية. وفي كتابة التاريخ نلاحظ أن المؤرخين درجوا على التأريخ للحكم وليس للدولة. فسيرة الحكام والخلفاء والولاة هي التي تحرك قلم التاريخ مع إهمال ملحوظ لبنية الدولة ومؤسساتها والمجتمع ودوره وتفاعله مع الأحداث إلى الدرجة التي توحي الكثير من الكتابات وكأن الشعوب لم تكن موجودة. وهناك استثناءات هامة منها كتابات ابن خلدون وأحمد أمين حيث احتل الجانب المجتمعي أهمية واضحة.
وبانهيار الامبراطورية العثمانية واستقلال الأقطار العربية كل في الحدود التي رسمتها اتفاقيات دولية تحكمت فيها القوى الاستعمارية (بريطانيا، فرنسا، ايطاليا) وقعت “المواجهة التاريخية غير المألوفة وهي حكم العرب لأنفسهم وإقامة الدولة الوطنية“.
وتركزت الجهود بل والصراعات بالدرجة الأولى حول السلطة والحكم (سوريا، العراق، اليمن ، ليبيا، الجزائر، تونس ، السودان، فلسطين، لبنان) وليس بناء الدولة الحديثة القادرة على الديمومة بإمكاناتها الذاتية والمتمتعة بمزايا وخصائص الدول المعاصرة ، ولتكون الدولة أم المؤسسات والأعلى والأسمى من كل اختلافات ونزاعات سياسية باعتبارها مؤسسة “الجميع” بغض النظر عن الأصول والعروق والمذاهب والجهات والأديان. وكانت الأقطار التي أخذت بالنظام الملكي (الاردن، المغرب، الخليج) أكثر استقراراً وتركيزاً على بناء الدولة وإن كانت الإدارة الحكومية تنجذب إلى السلطة والحكم، بدلاً من الإفادة من استقرار رئاسة الدولة لبناء المؤسسات والآليات الحديثة للإدارة.
وهكذا، فإن ازمه ” بناء الدولة بهويتها وخصائصها”. هي واحدة من الإشكاليات الكبرى المعاصرة في جميع الأقطار العربية. وانعكس ذلك على الجامعة العربية واخفاق محاولات التعاون والتكتل العربي والفشل في إحراز التقدم للتحول إلى دول صناعية ناهضة على غرار ما نراه في شرق آسيا.
(2) الثقافة المجتمعية
انعكس تاريخ المنطقة على الثقافة المجتمعية من جهة وثقافة النخبة السياسية من جهة أخرى. فالثقافة المجتمعية ذهبت باتجاه الاغتراب عن الحكومة والدولة من جانب والولاء لصاحب السلطة وليس للدولة الوطن من جانب آخر. اغتراب عن الدولة بمؤسساتها وبتفاصيلها وجزئياتها وبالتالي عدم الشعور بأهمية المحافظة عليها. وذهبت النخبة السياسية، وإلى حد ما الأحزاب، المذهب نفسه، وراحت تركز على دورها في السلطة فقط. وباستعراض الإنجازات هنا وهناك يلاحظ بوضوح أن العدد الأكبر ممن تقلد السلطة في أغلب الدول العربية كانوا مجرد سياسيين politicians وليس رجال دولة state’s men. وبطبيعة الحال ، هناك استثناء في كل بلد من أمثال بورقيبة في تونس ونوري السعيد في العراق ووصفي التل في الأردن وفارس الخوري في سوريا ..الخ. وهذا جعل من السهل على البعض من السياسيين أن يغامروا بمستقبل دولتهم من أجل السلطة (سوريا، اليمن، ليبيا).
إن الديموقراطية مثلا وباعتبارها إحدى الأركان الرئيسية للدولة الحديثة هي في وضع متدنٍ تماماً في المنطقة العربية ومتوسطها في الأقطار العربية 36% في حين أن المتوسط العالمي 56% . كما أن عدداً من الأقطار العربية
تصنف “كدول فاشلة” failed state في حين أن معظم الدول المتبقية تأتي مباشرة بعد الدول الفاشلة أي ما يسمى الدول الإنذارية، alert state.
لقد تعقدت نتائج ثقافة الحكم والسلطة لتنشأ عنها ممارسات لافتة للنظر وعلى النحو التالي:
أولاً: الاستعانة بالأجنبي من أجل الحفاظ على السلطة مهما كان هذا الأجنبي. وربما لا تجد منطقة في العالم تعتمد على الآخرين في معظم شؤون حياتها كما هو الحال في المنطقة العربية: ابتداء من الدفاع والسلاح ومروراً بالأجهزة والمعدات والخبراء وانتهاء بالكساء والدواء والغذاء.. فدول المنطقة العربية منذ الاستقلال حتى اليوم إما تعتمد على الدول الأوروبية والولايات المتحدة وإما تعتمد على روسيا وقبلها الاتحاد السوفياتي.
ثانياً: العصبية الجزئية مكان المواطنة والمؤسسية. أن الدولة العربية بدلاً من أن تجعل المواطنة هي الشبكة العصبية التي تحافظ على تماسك الدولة والتقاء أفراد المجتمع وآلية ذلك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقانون لجأت إلى العصبية الجهوية أو الطائفية أو العرقية أو الحزبية أو العسكرية وهذا النوع من العصبية بطبيعته قابل للفشل والانهاك والتمزق والشراء والتحالف مع الأجنبي .
ثالثاً: المساعدات من أجل الاستمرار. باستثناء الدول النفطية والتي يمثل النفط أكثر من 90% من مصادر دخلها فإن جميع الدول العربية تعتمد على المساعدات والمنح والقروض بدلاً من النهوض الجذري باقتصادات كل دولة أسوة بما نجحت فيه دول كثيرة صغيرة مثل سنغافورة الفقيرة في المصادر الطبيعية أو كبيرة الحجم والسكان مثل اليابان والصين. وترسخت لدى الادارات السياسية ثقافة المساعدات حتى بعد الثورات العلمية والتكنولوجية والمعرفية والرقمية التي جعلت رأس المال البشري أعظم مورد للدولة.
رابعاً: الفساد قبل النزاهة. ذلك أن الولاء للأشخاص أو للسلطة من شأنه أن يحول مسارات التفكير والسلوك من الموضوعية والمصلحة الوطنية إلى خدمة الحاكم وإرضاء مطالبه والتناغم مع رموزه سواء كان هذا النظام على نمط “القذافي” أو “علي صالح” أو “مبارك”، وبالتالي يتغلغل الفساد في كل مكان وعند كل مستوى.
وعليه ، فلا يمكن تحذير ركائز الدولة ورسم مستقبلها بإرادتها دون تغيير هذا المسار وهذه العقلية وهذه الثقافة ودون البدء بسيرورة جديدة يتوافق عليها المواطنون وتنقل المجتمع والأحزاب والنخبة والادارة الحكومية إلى آفاق جديدة تعزز بناء الدولة وترسخ الاستقلال بأبعاده المختلفة. وهذا يعني ضرورة تجاوز عقد التاريخ في بنية الدول العربية ليحل محلها متطلبات الحاضر والمستقبل.
(3) التهوين والتصغير
انطلق بناء الدولة الوطنية العربية القطرية الحديثة مع فترة الاستعمار والتي كانت على سيئاتها مناسبة إيجابية للتلاقي والتوحد والتماسك الوطني المجتمعي والعاطفي لمقاومة الإستعمار والتخلص منه. وكان كل شيء يتحرك بطيئاً ولكن إلى حد ما في الاتجاه الصحيح، باستثناء السلطة التي عمل المستعمر على إبقائها في قبضته. وراحت الأحزاب في التشكل والانتشار، والحريات السياسية إلى حد ما تظهر على السطح، إلا أن تلك المسيرة على علاتها بدأت بالتوقف أو التعثر بعد رحيل الاستعمار واشتداد سواعد الأحزاب السياسية ونخبة المثقفين والجيوش الوطنية. وبدلاً من البناء على إيجابيات التوافق الوطني إبان الفترة الاستعمارية عادت أنظمة الحكم لتتمسك بالعصبيات التقليدية باستثناءات قليلة في تونس والأردن ولبنان. ومرة ثانية، سيطر على الجميع فكرة تكاد تكون عامة وهي أن الانقضاض على الحكم يمثل بداية الطريق إلى الاصلاح والبناء والوحدة وكل شيء. أما التوافق على نظام لتداول السلطة كما فعلت ماليزيا بعد الاستقلال، أما المشاركة والعمل الديموقراطي أما الحريات والمؤسسية والمواطنة فكانت كلها بعيدة وخاصة في الحالات التي تدخلت الجيوش لإحداث التغيير . والنتيجة كانت إقصاء الآخرين والإنفراد بالحكم إلى حين.
ولعل التيارين الأممي والقومي كان لهما الأثر الأكبر في تكوين المفاهيم المجتمعية تجاه الدولة – الوطن. فالتيار القومي وخاصة في المشرق العربي رأى أن الدولة الوطنية التي استقلت ما هي إلا دولة “قطرية” رسم حدودها الاستعمار. وهي دولة وظيفية، لا مستقبل لها، ولا تستطيع أن تزدهر ولا تتقدم. ولذا ، فهي لا تستحق الكثير من الاهتمام أمام دولة الوحدة التي ستكون اشتراكية قومية غنية بالموارد. في حين أن التيار الاسلاموي كان يرفض كلاً من الدولة الوطنية والقومية ويتطلع إلى دولة افتراضية هي الخلافة التي يراد لها أن تضم جميع المسلمين 1200 مليون نسمة وتتوزع على أربع قارات بمساحات وحدود خارج إرادة أي شعب وفوق إمكانات أي إدارة. وبالتالي، راح هذا التيار يصغّر من شأن الدولة الوطنية ويعتبر أن مهمته ليس بناء الدولة الوطنية التي كثيراً ما يطلق عليها اسم “ولاية” وإنما العمل من أجل دولة الخلافة. وهكذا اتخذت الكثير من الأحزاب والجماعات القومية والأممية موقفاً سلبياً من بناء الدولة الوطنية واتخذت الحركات الاسلاموية موقفاً رافضاً للدولة الوطنية ولخصائص الدولة الحديثة من دستور إلى قانون إلى سلطة تشريعية الخ. وأدت أدبيات وممارسات الحكم والسياسة في المنطقة العربية وأدبيات الأحزاب القومية والأممية إلى اختلاط الأوراق في العقل المجتمعي وفي الثقافة المجتمعية. فمرة يسمع المواطن أن الديموقراطية لا تصلح لمجتمعاتنا ونحن غير مؤهلين لها بعد، ومرة يسمع أنه يجب أن تكون لنا ديموقراطية خاصة بنا (وهذا يدرس في الكتب المدرسية). ومرة يسمع أن القوانين السارية هي قوانين زائفة ومرة أن حل مشكلات الأمة ليس في الاقتصاد ولا في التعليم ولا في الثروة البشرية وإنما في دولة الوحدة أو دولة الخلافة وانتقلت كل هذه الاختلاطات والفوضى إلى الكتب والمناهج المدرسية والثقافة والإعلام. كل ذلك يجري على حساب بناء الدولة الوطنية الحديثة التي لن يكون بناؤها مستقراً دائماً إلا إذا كانت عصبيتها هي المواطنة المتكافئة للجميع ومفرداتها وخصائصها في اطار التوافق الوطني وإلا إذا كانت دولة حداثية واضحة للجمهور حتى تخرج المنطقة العربية وكل دولة عربية بذاتها من الولاء للحاكم إلى الولاء للوطن – الدولة وحتى تخرج من ثقافة الاعتماد على الأجنبي من أجل الوصول إلى السلطة إلى الاعتماد على قرار المواطن من خلال الانتخابات الحرة النزيهة وحتى تبدأ مرحلة جديدة تخرجها من حالة التخلف الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والسياسي والثقافي والدفاعي الذي تعاني منه إلى حالة الاعتماد على الذات واستثمار رأس المال البشري لديها.
كل ذلك يجري دون الإدراك الواعي لدى الكثيرين بأن الطريق إلى التكتل العربي والتوحد والوحدة والعمل المشترك هو بناء الدولة الوطنية القوية المنتجة المتماسكة على أسس حديثة لتكون ركناً راسخاً في تجمع أو تكتل أو توحد عربي. ودون الإدراك أن الدولة السلطوية أو الفردية أو الاوتوقراطية أو الدكتاتورية أو الشمولية هي دولة حكم وسلطة وإقصاء لا تقبل التجمع والتعاون إلا في حدود مصلحة الزعيم حتى لو أدى ذلك لأن يتحالف مع دولة مناوئة للعرب والعروبة ، ودون إدراك كل ما تقدم فستبقى الأقطار العربية تتحرك منفردة ومجتمعة في منزلقات تاريخية بالغة الخطورة.
(4) الدولة الحديثة
عند دراسة المؤشرات الأدائية للدول العربية يلاحظ الباحث أن الجزء الأكبر من هذه المؤشرات هو أدنى من المتوسط العالمي. وتأتي المنطقة في كثير من المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية في الطرف الأدنى من القائمة ولكن قبل افريقيا جنوب الصحراء سواء كان الأمر يتناول دخل الفرد أو البطالة والفقر أو الإنفاق على التعليم والفنون والثقافة والبحث العلمي أو دليل التنمية البشرية أو نصيب الفرد من الانتاج الصناعي أو الزراعي أو النزاهة أو سيادة القانون.. الخ. وهذا يعني أن التطلع نحو الدولة الحديثة العصرية القادرة على الإستجابة لمطالب وأشواق المواطنين أمر لابد منه. وفي خلاف ذلك تتعمق الصدوع والانقسامات في جسم الدولة وتصبح مهددة بالفشل. إذ لا يمكن التحرك بخطى بطيئة متخبطة مترددة في عالم سريع التغير متواصل التطوير على كل صعيد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم الاستجابة تعني استمرار حالة التخلف والضعف والهشاشة والظلم الاجتماعي والانساني.
وعلى مدى السنوات ، أخذت تتضح مطالب الجمهور وإصراره على التحرّك الحثيث نحو الدولة الحديثة باعتبارها البناء اللازم للمحافظة على إنسانية المواطن وسلامة الوطن وترسيخ الديموقراطية كنمط للإدارة والحياة وتداول السلطة بالطرق السلمية ووفق القانون. المشاركة المجتمعية في صنع القرار وفي انتخاب الحكومات والنواب والتعددية السياسية والفكرية والدينية والقومية بعيداً عن التشنج الايديولوجي ، والعدل وسيادة القانون وسلطته على الجميع والحرية المسؤولة والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المرأة وتمكينها وتعزيز دورها الاقتصادي الاجتماعي الفكري الإبداعي، والحاكمية الجيدة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد والتوجه بقوة وإرادة نحو الاقتصاد المجتمعي الصناعي وتعزيز البحث العلمي والتطوير والتكنولوجي والابداع وتطوير التعليم والفكر والثقافة والفنون و “رفع الضغوط عن العقول”. ومشاركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالحكم والمراقبة وتمكين الشباب وبناء الشخصية الوطنية الملتزمة بشؤون الوطن وتنمية المحافظات والبوادي والأرياف ووضع حد للفقر والبطالة.
(5) الأوراق والكلمات
هذه المفردات كثيراً ما وردت في كلمات وخطب ورسائل الملك عبدالله الثاني سواء في خطابات التكليف للحكومات أو في خطابات العرش أو في الرسائل إلى الحكومة والإرادات الملكية بتأليف لجان أو هيئات أو مجالس ملكية أو متخصصة وكذلك في الأوراق النقاشية السبع. كما وردت كلها أو أجزاء منها في الوثائق الوطنية اعتباراً من عام 1990 حين صدر الميثاق الوطني ثم الأجندة الوطنية ثم كلنا الأردن وغيرها. إلا أن المشكلة تمثلت في غياب الصفة القانونية لهذه الوثائق وفي نفس الوقت عدم أخذ موقف عملي تطبيقي ملزم قانوناً للدولة ولمؤسساتها. ولذلك بقي التأرجح سيد الموقف والخطوات البطيئة المترددة تسيطر على الحركة.
غير أن العديد من الاشخاص والجماعات والأحزاب عمدوا بسبب عدم ادراك حيوية التغيير وحتميته أو بسبب الثقافة المجتمعية إلى القفز عن هذه المطالب التي تمثل روح التطلع الاجتماعي الوطني. بل عمل البعض على الانقضاض عليها لإعاقتها دفاعاً عن مصالح فئوية أو لاختزالها في أطر سياسية أو أيديولوجية متكلسة متخشبة وجاهزة ربما من عشرات أو مئات السنين وغير قادرة على التفاعل مع العصر ومتطلباته. وراحوا يشيعون التخوف من التجديد ويرفضون الإعتراف بأن الماضي شيء والحاضر شيء آخر والمستقبل شيء مختلف جداً،وعلينا أن نبني وطننا من أجل المستقبل ونبدع ونبتكر كما ابتدع الآخرون. أما القوى السياسية التقدمية والمستنيرة والوطنية والمفكرون والعلماء والمثقفون وكذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية المستنيرة بل والمواطن العادي فكانت منحازة عن قناعة ورضا نحو تحقيق هذه الاهداف على طريق النجاح في بناء هذه الفصول في الدولة الأردنية الحديثة.
وبديهي أن هذه المفردات نجدها في منتهى الفعالية في الدول المتقدمة، وغيابها أو إفراغها من محتواها أو الالتفاف عليها يعني بالضرورة سيادة ما هو عكسها أي السلطوية والفساد واستمرار كل ما يشكو المجتمع منه على ذات الحال. بمعنى أن غياب الديموقراطية والمشاركة المجتمعية يؤدي إلى الانزلاق في فكر وسلطة المجموعة أو النخبة أو الفئة وبالتالي الدكتاتورية الفردية أو الفئوية. كما أن غياب التعددية السياسية والفكرية والمعتقدية والقومية يعني الإقصاء للآخر وخلق ضغوط اجتماعية داخلية. وإذا غاب العدل ولم تتحقق سيادة القانون وسلطته على الجميع دون استثناء تحول الأمر إلى الظلم و الفساد. كما أن ضعف الحريات وانتقاص المواطنة وغياب المساواة وتكافؤ الفرص يؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي والفساد والمحسوبية. وبدون تمكين المرأة وتمتعها بحقوقها فإن المجتمع يعمل بنصف طاقته الاقتصادية والانسانية والابداعية وهو بذلك لن يتجاوز حدود الحالة المتأرجحة بين النجاح والفشل. وبدون الحاكمية الجيدة والمساءلة والشفافية فإن الدولة تغرق في بحور من الفساد والتسلط والقرارات الكارثية على كل صعيد. وليس من بديل عن الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتكون الأجهزة التي تعمل بانتظام وتراقب وتحاسب، وبدونها تتحول الإدارة إلى السلطوية. إن تمكين الشباب وتنمية المحافظات يمثل العدالة الإجتماعية الأفقية والعمودية في المجتمع والإستعداد للمستقبل واستثمار كافة الإمكانات. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابداع والابتكار والتعليم المتطور والفكر المستنير والثقافة المتقدمة المعاصرة والفنون الراقية. إن كل هذه الأهداف والمفاصل تتطلب استثمارات مالية وبشرية وفكرية ضخمة ودائمة ولا تتحقق إلا بتطوير الاقتصاد الوطني ليخرج من الحالة الريعية وعصر ما قبل الصناعة، إلى الحداثة أي التحول إلى اقتصاد اجتماعي صناعي كما فعلت الدول الناهضة.
والسؤال: ماذا يمكن تسمية الدولة أو ما هي الهوية التي يمكن أن تعطى للدولة التي تتميز بفاعلية هذه المفردات وقوتها وكفاءتها؟ ليست الدولة العسكرية والسلطوية ولا الأوتوقراطية ولا الدولة الدينية ولا الدولة الفاشلة ولا الدولة الانذارية ولا دولة الأقليات ولا الدكتاتورية. إن الدولة التي تفعل هذه المفردات وتديمها هي الدولة المدنية.
(6) الدولة المدنية
أن هذا التعبير ليس موجوداً بكثرة في الأدبيات السياسية العالمية بهذا المعنى. وهو تعبير تم استخدامه للخروج من “القنص اللغوي”. ذلك أن المنطقة العربية من أكثر المناطق في العالم التي يجري فيها التعامل مع المصطلحات الجديدة بكثير من القلق والتوتر والتشنج أحياناً والاقتناص بهدف الرفض وإخافة المجتمع حتى لو كان الموضوع (وليس المصطلح) اعتيادياً بل وقائماً منذ عشرات أو مئات السنين. يعود ذلك في جزء كبير منه إلى هاجس التمسك بالماضي أو بالأيديولوجيا، وعدم قبول التجديد والمستحدث.
لقد تم استعمال هذا التعبير حتى لا تكون هناك فرصة لمن هو غير متبصر بطبيعة التحولات في العالم لمحاربة مشروع النهوض والتحول، حفاظاً على المصالح والمكاسب التي تحققت للبعض على مدى سنين من عدم استكمال مشروع “الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة”.
وهذا التعبير أصبح شائعاً بل ومقبولاً لدى الأوساط السياسية والفكرية والدينية المستنيرة لأنه يمثل جوهر الدولة الوطنية المنبثقة عن الشعب والتي تعمل من أجله.
إن المجتمعات المعاصرة هي مجتمعات مدنية بمعنى انها ليست وإنما هي أفراد ومجموعات بينها حياة مشتركة وفق تعاقد يمثل قوانين المجتمع واعرافه وثقافته. مجتمعات بينها وبين السلطة نوع من التعاقد المعلن ممثلة بالدرجة الاولى بالدستور والتشريعات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
وبالتالي ، فإن مشروع الدولة المدنية تمثله الدولة القائمة فعلا والذي يتطلع المواطن والمثقف والمفكر والملك إلى استكمال مشروعها بفاعلية وكفاءة.
(7) التطلع والأوراق
إذا رجعنا إلى الأوراق النقاشية السبع التي أطلقها الملك خلال السنوات الخمس الماضية نلاحظ أنها ركزت على الفصول التي أشرنا إليها وخاصة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية والسلوكية. فالورقة الأولى ركزت على بناء الديموقراطية المتجددة والحوار والتشارك والانتخاب والتنافس العادل واحترام الرأي الآخر على أساس الشراكة وواجب المساءلة لاكتمال المواطنة ثم التوافق الوطني وصناعة مستقبل الأردن. وأشارت الورقة الثانية إلى تكوين المجتمع الديموقراطي ومبادئ المواطنة وإلى الانتقال إلى الحكومات البرلمانية وإلى الحاجة لأحزاب وطنية فاعلية، ومن ثم إلى الادارة وتطوير نظام الخدمة جميع الأردنيين. وفي الورقة الثالثة، كان التركيز على الحكومات البرلمانية والتعددية والتسامح وسيادة القانون والتوازن والفصل بين السلطات والبرامج الوطنية للأحزاب ثم الاهتمام بالمستقبل والأدوار التي ينبغي القيام بها. وركزت الورقة الرابعة على التمكين الديموقراطي والمواطنة وفاعلية العمل الوطني والمشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز منظمات المجتمع المدني وترسيخ دورها في مراقبة الأداء السياسي وترسيخ ثقافة الديموقراطية وحق المواطن في العمل السياسي والالتزام بواجباته، ثم المساءلة والشفافية وإتاحة الفرص، بينما تناولت الورقة الخامسة موضوع الأهداف والمنجزات وتطور الجهاز الحكومي والأحزاب وبناء قدرة القضاء وتعزيز النزاهة الوطنية ودور الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات والقطاع الخاص في إنتاج الأفكار والأبحاث والإستثمار في البحث العلمي وابتداع الحلول للمشكلات التي تواجهها الدولة. وجاءت الورقة السادسة لتشير إلى سيادة القانون ومكافحة الفساد والدولة المدنية التي تلتزم بالقانون والعدل والمساواة وتقبل التنوع وترفض الإقصاء. وأشارت إلى التعددية الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية ليكون هذا التعدد مصدراً للإزدهار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. وعادت لتؤكد على سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب للإبداع والإنتاج وضرورة المراجعة والتقييم لأعمال المؤسسات في إطار المساءلة لمعالجة القصور والتخلص من الواسطة والمحسوبية وتطوير القضاء ومن ثم اعتماد مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة حتى لو اختلفت الأديان، وبالتالي الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة،دولة القانون والدستور والتعددية والمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب. وجاءت الورقة السابعة لكي تركز على التعليم وتطوير الموارد البشرية للدولة والتأكيد على عدم تسييس التعليم باعتباره مسألة وطنية فوق كل المناكفات والخلافات.
(8) وماذا بعد
وهكذا ، فإن “الدولة المدنية” ليست شيئاً غريباً أو غير مألوف. بل إنها الدولة الوطنية حين تستكمل متطلبات الحداثة والتي تقوم على الركائز التي أشرنا إليها وأصبحت هذه بالواقع مطالب جماهيرية ونخبوية على حد سواء وأثبتت فاعليتها وكفاءتها وقيمتها في المحافظة على تماسك الدولة وحيويتها وارتقاء الإنسان وسعادته في العديد من دول العالم الصغيرة والكبيرة على حد سواء. ومن هنا، فان تأتي الأوراق النقاشية لتذكرها وتؤكد عليها بل وتطالب بها فذلك مؤشر بالغ الأهمية على التوافق الوطني من رأس الهرم إلى قاعدته بضرورة الانطلاق إلى العمل.
وهذا يضع على الحكومة وبالتعاون مع القوى السياسية والمدنية مسؤولية الدعوة إلى مؤتمر وطني عام يتم فيه إقرار الدولة المدنية الحديثة وفق الفصول السابقة. ويصاغ هذا الإقرار في وثيقة وطنية شاملة (على غرار الميثاق الوطني لعام 1990) وتعرض على مجلس الأمة لاقرارها كوثيقة ملزمة للحكومات ولدوائر الدولة. وفور إقرارها من مجلس الأمة وصدور الارادة الملكية فيها تبدأ المؤسسات الرسمية بوضع برامج العمل للإنتقال والتحول وفق برنامج زمني على طريق بناء الدولة الأردنية المدنية الحديثة.