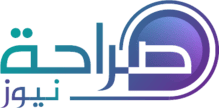صراحة نيوز بقلم الدكتور محمد خير الحوراني
جميل جداً أن يتعاظم الاهتمام بالبحث العلمي و أن يكون موضوعاً للعديد من المقالات و أن يطرق كل يوم لأهميته البالغة، و جميل جداً أن يكون هناك وزارة نصف اسمها للبحث العلمي “وزارة التعليم العالي و البحث العلمي” و في المقابل تلمس أن هناك خلطاً في أمور البحث العلمي فتجد الكثيرين يتحدثون عن البحث العلمي و كأنه غاية لا وسيلة كما أن البعض حصره في زاوية ضيقة من المجتمع و مرافق الدولة و هي الجامعات و ما أن يذكر البحث العلمي حتى تقفز الجامعات الى الأذهان و كأنها هي الوحيدة المسؤولة عن البحث العلمي دون غيرها، فهل الجامعات هي فقط صاحبة الوصاية على البحث العلمي، و حتى الجامعات نفسها تتأهب للدفاع عن نفسها كلما ذكر موضوع البحث العلمي فهل البحث العلمي مسألة جامعة أو جامعات أم مسألة مجتمع ومسألة دولة بأكملها. كما يطفو على سطح صحفنا و مجلاتنا بين الحين و الحين أن ما ينفق على البحث العلمي في الدول النامية عموماً و الدول العربية و الأردن خاصة أقل من 1% من إجمالي الدخل القومي ثم قد تقرأ في نفس الصحيفة أن هناك فائضاً لم يستغل في موازنة صندوق البحث العلمي أو موازنات الجامعات، فكيف تقرأ هذه التناقضات!؟
البحث العلمي غاية أم وسيلة
لا شك أن البحث البحث العلمي وسيلة لا غاية بحد ذاتها و هي طريقنا إلى التطور و النمو و بما أنه وسيلة لا غاية، لا يرد اسمه في كثير من الأحيان بمعزل عن ما يهدف إليه و لذا نجد في كثير من الأحيان أنه يشار إليه على الهيكل التنظيمي لشركات الانتاج و المصانع بدائرة البحث و التطوير (R & D Department ) فالهدف من البحث العلمي هو التطوير و لا تطور دون بحث علمي.
فالبحث العلمي إذا له غرض و له هدف و هو التطوير و في البلدان الصناعية يرصدون المبالغ الضخمة للتطوير بمنهجية البحث العلمي في مجالات عديدة. شركات السيارات مثلاً تضع موازنة لتطوير المحرك و بنداً آخر في الموازنة لتطوير الهيكل الخارجي و تضع بنداً لتطوير نظام التعليق و البلدان المهتمة بغزوالفضاء تضع بنداً لتطوير الإتصالات مع رواد الفضاء و بنداً للتحكم الروبوتي بالمركبة و غير ذلك، و وزارة الزراعة تعتمد البحث العلمي في مكافحة الحشرات الضارة و الآفات الزراعية على إختلاف أنواعها.
أما في بلدان العالم الثالث، الفقيرة صناعياً فالصناعات الموجودة لديها ليست أصيلة و لا مبتكرة و يقتصر الدور في استعمالها على دور المستخدم و بحكم أنها صناعات وافدة فلا تكلف إدارات تلك المؤسسات نفسها عبئ و جهد تطويرها لأن الذي أنشأها أول مرة أقدر على تطويرها من حيث العهد بها و قس على ذلك في مختلف نواحي الحياة. و في بلدان العالم الثالث انتفى القصد و الهدف الكبير و هو التطوير عن البحث العلمي و فقد دوره الهام و الغرض منه و جرت عليه قوانين الاهمال و الاستعمال و تلاشى في ركن وحيد في المجتمع و هو الجامعات و لذا برز إسمه في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
وإنتفاء الغرض الحقيقي للبحث العلمي جعله ينكفأ على نفسه و يضمر و يضمحل و يتقوقع في بوتقة ساذجة الغرض منها هي الحصول على رسائل الماجستير أو الدكتوراه بالنسبىة لطلبة الدراسات العليا أو الترقيات العلمية بالنسبة لأساتذة الجامعات و أصبح هذا هو النمط السائد في البحث العلمي. و لا بد من التأكيد هنا على أن الغرض من البحث العلمي في الجامعات هو دور تدريبي في الدرجة الأولى أي أن الطالب يقوم بإجراء البحوث في هذه المرحلة ليتدرب على أصول البحث العلمي و منهجية البحث العلمي و لذلك هو جزء أصيل من رسالتها.
نحن في الأردن كمثال لدينا بضعاً و ثلاثين جامعة تكرست خبرة بعضها لما يزيد على ربع قرن و زادت البحوث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس فيها إلى الآلاف من البحوث و لكن بكل أسف لم نسمع أن واحداً من هذه البحوث وضع موضع التطبيق لا في حل مشكلة قائمة و لا في تطوير مرفق أو آلة أو جهاز أو غير ذلك إلا ما ندر و يعد عدم وجود مثل هذا الانجاز مؤشرا على ضحالة و ضآلة مخرجات البحث العلمي و إن وجد و لم نسمع به فهذا مؤشر على تقصير شديد من جانب المجتمع في حق الباحثين و العلماء في الوقت الذي يسلط فيه الضوء على أصحاب أنصاف و أرباع و أعشار المواهب الفنية و الأدبية.
كم نحن بحاجة إلى إشاعة ثقافة البحث العلمي و أن تأخذ وسائل الاعلام على نفسها هذه الرسالة و كذلك كل مؤسساتنا التعليمية إبتداءً من رياض الأطفال و أن نهتم بمعلمينا و أن تترسخ لديهم ثقافة أن ينقلوا إلى طلبتنا منذ صغرهم أهمية منهجية الوصول إلى المعرفة و ليس نقل المعرفة و كأنها جاءت بطريقة الإلهام.
ما أحوجنا إلى تعميم مسؤولية البحث العلمي ليكون في كل مؤسسة كبيرة صناعية أو إنتاجية أو زراعية أو خدمية وحدة تنتهج المعرفة و تضع الحلول بطريقة البحث العلمي في التطوير و حل المشكلات. لقد تعقدت المجتمعات كثيراً و أصبح الركون إلى الإلهام و الرؤى المجردة في حل مشكلاتها الصناعية و الاجتماعية و التربوية و الاقتصادية سذاجة ما بعدها سذاجة و لربما ما أحوجنا إلى جيل جديد من قادة مؤسسات الدولة و مؤسساتها الاجتماعية و الإقتصادية و الصناعية يقودهم البحث العلمي لحل المشكلات لا الرؤى و الالهام الفردي فإن نجح الالهام في مسألة فقد يؤدي إلى كوارث و مصائب في عشرات المسائل الأخرى.
البحث العلمي في شأن البحث العلمي
بين الحين و الحين، يطل علينا كثير من الكتاب و ينتقدون البحث العلمي في جامعاتنا تحديداً أو في إنفاقنا على البحث العلمي مقارنة مع الدول الصناعية و تجد الكثيرين ينصب اهتمامهم على الكم دون الدخول في المضامين.
وأرى أننا بحاجة لتوظيف البحث العلمي و أدواته الموضوعية في الحكم الموضوعي على كثير من الأمور المتعلقة بالبحث العلمي، أين أساتذة كليات التربية و علم الاجتماع من طرق هذه الأبواب و الإجابة على أسئلة دقيقة مثل لماذا أغفلنا البحث العلمي في حل مشاكلنا على كافة الصعد؟ لماذا تقزّم البحث العلمي و تقزّمت أغراضه و أهدافه؟ لماذا أقتصر البحث العلمي على الجامعات؟ أين مراكز البحث العلمي المتخصصة في شؤون المجتمع الأخرى؟ ما أهمية البحث العلمي القائم حالياً في جامعاتنا أو في غيرها إن وجد؟ كم من البحوث المنشورة أسهم في حل مشكلة محلية أو عالمية؟ كم من باحثينا نال صاحبه تقديراً عالمياً أو محلياً؟ كم من براءات الاختراع شق طريقه إلى التطبيق العملي و كم منها بقيت دفينة الأدراج لا قيمة لها أكثر من الورق الذي كتبت عليه؟ و ما مستوى البحث العلمي التي ينتج في جامعاتنا؟ و لماذا يقوم الباحثون عندنا بالبحث العلمي أصلاً و ما هو الدافع أو الحافز وراء بحوثهم؟
و هذه دعوة للباحثين من إحصائيين و علماء إجتماع و تربية و صندوق البحث العلمي للبحث لإيجاد جواب شاف لكل هذه الأسئلة لأن في الجواب عليها وقوفاً على واقع البحث العلمي، و بكل تأكيد وقوفنا على واقع البحث العلمي سيسهم في التخطيط طويل الأمد في توطين البحث العلمي و ليكون أداتنا في رسم خارطة طريق إلى المستقبل.
البحث العلمي و الجامعة و المجتمع
لقد أوردت العديد من التساؤلات و لن أنبري للإجابة عليها لأنني حينئذ سوف أناقض نفسي و هي دعوتي للمختصين للإجابة عليها، و لكن هناك مسألة هامة يمكن أن تشكل المظلة لكل هذه التساؤلات و هي العلاقة بين الجامعة و المجتمع.
الجامعات في الدول المتقدمة انفتحت على المجتمع كما انفتح المجتمع عليها بكل المقاييس ، حتى من الناحية الفيزيائية الجامعات على ما رأيت ليست جامعات مسوّرة و ذابت الحدود الفيزيائية بين الجامعة و المجتمع لصالح الجامعة و لصالح المجتمع، و رأى المجتمع في الجامعة بيت خبرة و عدداً هائلاً من الخبراء في كل ضرب من ضروب المعرفة فأتجه إليها لحل مشكلاته و وفر لها الدعم و زادت ثقته بها يوماً بعد يوم و في تلك الجامعات وضعت سياسات خارجية لدول و في الجامعات طورت نظم إقتصادية و في الجامعات حلّت مشكلات بيئية و زراعية و صناعية و مرورية. في دول العالم المتقدم، حافظ المجتمع بوعيه على الجامعة لتكون مكاناً للريادة العلمية و الفكرية و الأدبية و دعم استقلالها الفكري و رفع القيود عن التفكير الحر أياً كانت فأثمرت التجربة الجامعية إختراعاً و إبداعاً في كل ضرب من ضروب الفكر و المعرفة.
وفي المقابل، في الدول النامية، أنشأت جامعات فكانت كأنها جزر معزولة تحيط بها أسوار عالية و سميكة لتفصلها عن المجتمع و لتفصل المجتمع عنها فتكرست عزلتها و غزاها المجتمع لينقل إليها كل ما فيه من علل حتى باتت الجامعات و المجتمع كالأواني المسطرة لا يفضل أحدهما الآخر و فقدت الجامعات ريادتها و استقلالها الفكري قبل المالي و الإداري و أصبحت مجرد “حارات” من حارات المجتمع.
وإذا أردنا للجامعات أن يكون لها دورها الحقيقي فلا بد من إعادة ترسيم الحدود بين الجامعة و المجتمع لتكون الجامعة مستقلة فعلاً ليس من الناحية الإدارية و المالية فقط بل و من الناحية الفكرية و العلمية و في اللحظة التي تتمتع الجامعة بإستقلالها و يكون لها هويتها و لطلبتها هويتهم و إنتمائهم الجامعي لن نسمع حينئذ عن العنف الجامعي الذي تغذية نعرات و آفات إجتماعية ترعرعت في المجتمع.
لا بد من أن تعي الدولة الأردنية و بأعلى مستوياتها أهمية الجامعات ليس في تزويد المجتمع بالقوى البشرية العاملة بل تتجاوزها إلى أن الجامعات تمثل أكبر مخزون للطاقات الفكرية و العلمية و أنها قادرة إن أتيحت لها الفرصة و انتهجت سبيل البحث العلمي أن تساهم في حل مشكلات المجتمع الحالية و استشراف مستقبله.