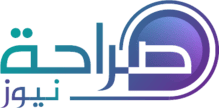صراحة نيوز – بقلم الأمير الحسن بن طلال
تدعونا مراجعة التجربة الدولية والإنسانية خلال خمسة وسبعين عاماً، هي عمر منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في مدينة سان فرانسيسكو بتاريخ 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1945 وحتى هذا العام، إلى وقفة تأمّل وتقييم لهذه المسيرة وحصيلتها التاريخية، بروح عالية من الموضوعية والضمير الحرّ، والنظرة الكليّة إلى عالمٍ ما يزال يعاني أشكالاً شتى من الصراعات والحروب والاحترابات والأزمات والكوارث، وفي الوقت نفسه يقف على حافة المصير إما بالتفكك ومزيد من التباعد والتنافر؛ ومن ثم الغرق في مأزقه، أو بتجاوز محنته الكبرى إلى جهد تضامني أممي، واسع النطاق والرؤية والعمل الجاد، يتحمّل مسؤولية النهوض به مؤسَّسياً الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ويتضامن الجميع في إطار هذا الجهد على أساس التكافؤ في خدمة الصالح الإنساني وسلام البشرية.
تذكّرني الاحتفالية المقبلة الشهر القادم بذكرى تأسيس الأمم المتحدة بمناسبة أُخرى هي ذكرى إطلاق “نداء جنيف لدعم القانون الدولي الإنساني”، قبل عقدين من الزمان في مثل شهر آب (أغسطس) الماضي، وتحديداً في الثاني عشر منه عام 1999 عندما تنادت أربع عشرة شخصية من أرجاء العالم المختلفة، شرفتُ أن أكون بينهم، لدعوة الشعوب والأمم والحكومات إلى نبذ فكرة حتميّة الحرب، والعمل بلا كلل لاجتثاث جذور مسبباتها، ومطالبة أطراف النزاعات المسلحة وجميع من هم في مواقع التأثير على مجريات تلك النزاعات باحترام المبادىء والقواعد الجوهرية الواردة في القانون الدولي الإنساني، وبذل الجهود لتجنيب المدنيين ويلات الحروب . واعتمد النداء المبادىء التي ألْهَمَت وضع اتفاقيات جنيف قبل ذلك بخمسين عاماً كأساس لتعزيز العلاقات بين الجميع، ومن أجل احترام الكرامة الإنسانية في مختلف الظروف، والتعاطف مع ضحايا المعاناة ومعاملتهم وفق ذلك، وتأكيد التضامن بوصفه نهجاً وقيمة وضرورة إنسانية أكثر من أي وقتٍ مضى.
إنَّ ما تعرضت له اتفاقيات جنيف المُبرَمة على إثر الحرب الكونية الثانية من انتهاكات عديدة على مدى سبعين عاماً، لا يعني أنها غير صحيحة ولا جدوى منها، وكذلك الأمر في البناء على جوهر ميثاق الأمم المتحدة، وما تبنته جمعيتها العامة في مطلع ثمانينيات القرن العشرين من فكرة بناء نظام إنساني عالمي جديد، وقد كان لي شرف الإسهام في بلورتها وطرحها آنذاك. غير أن العبرة تتمثَّل في تكامل الجهود وصدقيتها في العمل على تحقيق الأهداف السامية من قبل جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة، وبلا استثناء؛ بل وكبيرها قبل صغيرها، وقويّها قبل ضعيفها، وغنيّها قبل فقيرها، لأن البديل متغيّر ولا يُنتج إلا تهديداً مباشراً للبشر والبيئة والحقوق المشروعة للشعوب والدول، جراء أجندات ضيقة لأقليّات سياسية في العالم تُكرّس علاقات القوة بدلاً من علاقات التضامن الإنساني، والتعاون من أجل الاستقرار والتنمية الشاملة، وإرساء أسس السِّلم وأركانه الصالحة لصنع مستقبل البشرية.
وحين ننظر إلى نتائج المحاباة للدول المنتصرة في الحرب الكونية الثانية عبر آليّات الأمم المتحدة منذ إنشائها، سندرك كم كانت هذه النتائج غير منصفة بحق دول أخرى وبحق مناطق في العالم لم تعرف منذ سنين طويلة غير المعاناة والقلق الدائم، وعُسر التخلص من أسباب النزاعات والصدامات والحروب. علينا أن نتوقف في هذا الوقت بالذات الذي تضرب فيه جائحة كورونا مناطق شاسعة من العالم؛ أمام مقولة إن البشر يقتلون بعضهم بعضاً في الحروب والنزاعات المسلحة أكثر مما تخلفه الجوائح من ضحايا، لنجد أن إحصائيات الحروب الثنائية والإقليمية بعد حربين عالميتين ضاريتين، ومنذ منتصف القرن الماضي، شكَّلت معاناة ممتدة للبشرية على جغرافيتها الأرضية من شرق آسيا حتى أميركا اللاتينية، مروراً بإفريقيا وأوروبا الشرقية بما في ذلك غرب آسيا وشمال إفريقيا.
والحديث عن تقييم واقع الحال الدولي يقودنا إلى النظر بخشية وحذر نحو ما يجري في هذا الجزء من العالم الذي تعارفنا على تسميته باليورومتوسطي، والذي طالما كانت الأفكار والآليّات المطروحة للتعاون بين أطرافه في الشمال والجنوب قادرة على أن تحقّق في المحصلة النهائية إنجازات تعود بالخير على هذه الأطراف بمجملها، فتجعل من منطقة البحر المتوسط نموذجاً في التعاون الإنساني والسلام المتكافىء، بعد أن عانى شرق المتوسط طويلاً من حروب إقليمية بسبب انتفاء الإيمان بالعدل والسلام لدى بعض الأطراف.
لكن بعد أن كان الأمل معقوداً على القناعة بإقامة السلام العادل والشامل الذي يعيد للفلسطينيين حقوقهم المُعترف بها وفق الشرعية الدولية، عُدنا إلى نقطة الصفر وضبابية المشهد، وكأن ثلاثة عقود من المد والجزر منذ مؤتمر مدريد وما تم توقيعه من اتفاقيات السلام، لم تكن كافية لبناء تلك القناعة عملياً. وفيما انتهت في الشمال معاناة الإنسان في حرب البلقان، فإننا نجد الواقع المتوسطي الجديد يتجاوز ما عانته بعض دول شرق المتوسط من احترابات وصراعات مريرة، إلى موجاتٍ من الهجرة واللجوء عبر المتوسط شكَّلت بدورها مآسٍ ومعاناةً شهدها وتأثر بها الضمير العالمي، لكن الإرادة الدولية لم تتكاتف بالمستوى المطلوب لوضع حلولٍ موضوعية ونهائية لأسباب هذه المعاناة الإنسانية، وهي في حقيقتها معاناة للمسلمين أكثر من غيرهم كون 80 بالمئة من لاجئي العالم هم من أتباع الديانة الإسلامية.
إنَّ إحياء التعاون الأوروبي المتوسطي أو بين ضفتي المتوسط وتطوير عملية برشلونة، عملية مرتبطة في الراهن بمواجهة قائمة من التحديات تبدأ بالهجرة غير الشرعية واللجوء، ولا تنتهي بالتعاون من أجل مواجهة خطر تداعيات ڤيروس كورونا المستجد على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية . لكننا نجد أن ضفاف المتوسط مقبلة على تسخين من نوعٍ جديد، وعلى درجة عالية من الخطورة، هو في المنظور الإنساني الموضوعي غير مبرر، ونأمل ان لا يقع طرفا التسخين، وهما عضوان في حلف الناتو، في فخٍّ يمثل المزيد من خسائر لا تقتصر عليهما، وإنما ستشمل جميع مَنْ حولهما. فاحترام قواعد القانون الدولي وإعمال مبادىء الشرعية الدولية في حلّ النزاعات، هو أحد شروط قبول عضوية الدولة في الأمم المتحدة أصلاً، ومحاولة أي دولة عضو في الأمم المتحدة التحايل على الحلول السلمية واللجوء إلى فرض الحلول بالقوة، تظلّ محاولة بائسة لن تؤدي إلا إلى تسميم العلاقات بين الدول، ولا يمكن أن تنتهي الى حلولٍ دائمةٍ.
من هنا نتساءل بعقل نقدي يستند إلى فلسفة القيم :هل اكتشاف ثروات نفطية في شرق المتوسط سيصبح نقمة على شعوب المنطقة؟ وهل يلغي الطمع حكمة العقل والضمير الإنساني والعدل وسيادة القانون؟ هل يعجز الحوار في إطار القانون الدولي وقانون البحار عن تقديم الحلول العادلة بين الدول المتجاورة؟ وهل العقل البشري بكل قدراته العلمية الخيّرة التي اخترعت للبشرية ما يجعلها أكثر سعادة، سينحاز الى قدرات تعمل بعكس ذلك من أجل علاقات قائمة على القوة، تنفي الآخر عقلياً، وتؤكد الاختلاف، وتستبعد أي بحث عن المشترك والالتقاء في فضائه؟!
لعل استحقاق النهضة الحضارية الشاملة في هذه المنطقة من العالم يقتضي من إسرائيل أن تواجه نفسها أولاً لتجيب عن سؤال بسيط لكنه أساسي، فهل تريد أن تكون جزءاً من الشرق الأوسط إنسانياً وحضارياً وثقافياً واقتصادياً، إضافة الى وجودها الجغرافي؟ من الطبيعي أن تكون الإجابة الحقيقية عن هذا السؤال منبثقة من إرادة صنع السلام، واحترام الشرعية الدولية، والرغبة في وضع قواعد جديدة للتعاون الحضاري الإنساني .
ويبقى أن لا نفقد الأمل بأن هذا الشرق الأوسط بمكوناته الديموغرافية لديه الإمكانات لأن يعطي الرسالة الأفضل في الحوكمة الرشيدة لآليّات عمل منظمة الأمم المتحدة وإصلاحها وتطويرها بإرادة ذاتية من داخلها، والإسهام في صياغة جديدة للعلاقات الدولية قائمة على الشراكة الواعية والمُبصرة للمصالح الأسمى في تحقيق العدالة والمساواة والحياة الإنسانية الكريمة للشعوب والأمم المتجاورة .